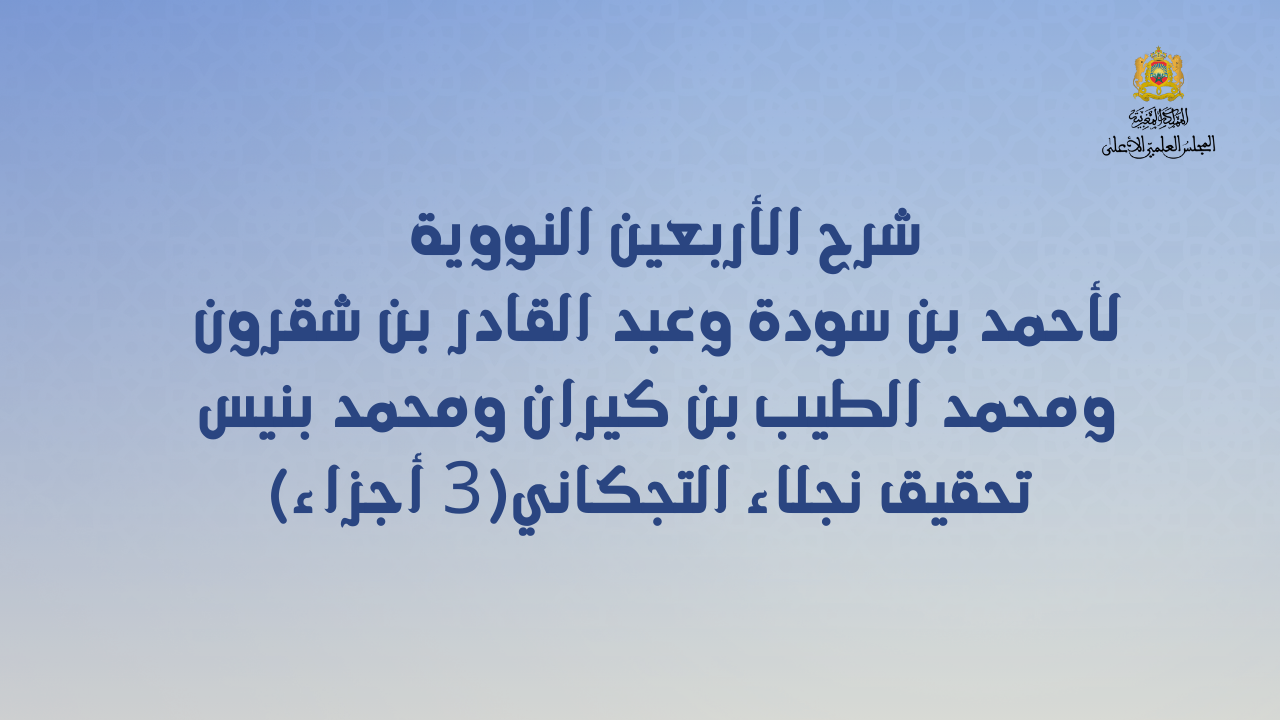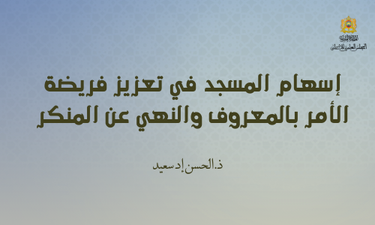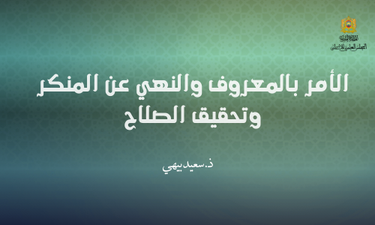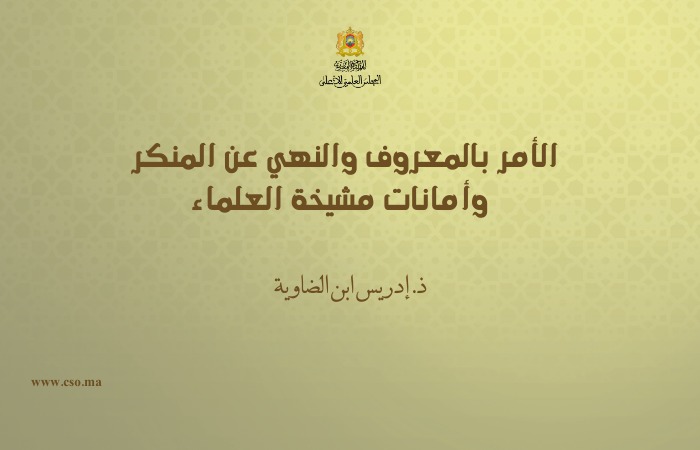خطة تسديد التبليغ أركانها ووسائلها وغاياتها:ذ. الحسن إد سعيد عضو المجلس العلمي الأعلى
خطة تسديد التبليغ
أركانها ووسائلها وغاياتها
ذ. الحسن إد سعيد
بسم
الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين.
وبعد،
فصلة بموضوع ورش تسديد التبليغ الذي انتهضت به مؤسسة العلماء بالمجلس العلمي
الأعلى بتوفيق من الله تعالى، وبوعي ومسؤولية بحاجة المجتمع في هذا الوقت أكثر من
أي وقت مضى لحمايته من الفتن وأصحابها، ولإسعاده ليعيش حياة طيبة كما أراده الله
تعالى ووعده بها، ووعده حق، والإيمان بوعده واجب، جاءت هذه الورقات للحديث عن مهمة
التبليغ وأركانها ووسائلها وغاياتها، إسهاما بجهد المقل في هذا الورش الكبير الذي
وفق الله تعالى إليه ونبه عليه.
وليس
بشيء جديد في دعوة الإسلام، ولكن كأنه مغفول عنه ومشغول عنه بالاهتمام بالشكل دون
المضمون كثيرا تارة، وتارة باحتراف المهام الدينية، والنظر إليها على أنها مصدر
رزق ليس إلا. وهاتان النقطتان تفرغان مهمة التبليغ من مضمونها تفريغا، وتبعدانه عن
أداء مهمة التبليغ التي هي وظيفة الرسول ﷺ، والنائب عنه فيها لا بد أن يسلك بها
مسلكها الصحيح، من تشخيص الأدواء النفسية والاجتماعية المختلفة ووصف الدواء الناجع
لها، بتزكيتها بالإيمان حتى تطمئن النفوس إلى ما عند الله تعالى أكثر مما تطمئن
إلى ما تملك بين يديها، وتحليتها بالعمل الصالح بكل ما تعني الكلمة من معنى، وهذا
هو المراد ب"تسديد التبليغ"، حتى يؤتي ثماره المرجوة منه، من
صلاح الفرد والمجتمع، في سائر الأحوال.
وليس العمل
الصالح محصورا في العبادات على أهميتها في موضوع التبليغ وإصلاح الفرد والمجتمع،
بل يمتد معناه إلى كل تصرفات المسلم في جميع مناحي حياته وفق مراد الله تعالى فيه؛
حتى ترتقي عاداته إلى عبادات، فيحقق معنى قوله، ﷺ: "إنما الأعمال
بالنيات". أي كل الأعمال.
وسأتناول
الموضوع بإذن الله تعالى وحسن توفيقه على الشكل الآتي:
تمهيد
وتعريف
أولا: أركان
التبليغ الأربعة:
المبلغ
عنه، وأهمية معرفته والإخلاص له في التبليغ.
المبلغ،
صفاته وشروطه لأداء مهمته على أحسن وجه وأكمله.
البلاغ،
حقيقته ومعالمه وحدوده
المبلغ
إليه، صفاته وشروط التأثير فيه ومراعاة حاجاته وظروفه.
ثانيا: وسائل
التبليغ:
الوسيلة
الأولى: فقه النص الشرعي كتابا
وسنة، ويتطلب:
1- المعرفة باللغة العربية
معرفة كافية لإدراك مرامي النصوص ومغازيها.
2- المعرفية بعلوم القرآن
والسنة وكيفية أخذ الحكم والأحكام منها.
3- المعرفة بالفقه وأصوله
ومناهج العلماء في استنباط الأحكام.
الوسيلة
الثانية: فقه الواقع الذي يعيشه
المبلغ ومعه الفئة المستهدفة بالتبليغ، ويتطلب:
1-
معرفة واقع الناس الديني والدنيوي
2-
معرفة أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم.
3-
معرفة العلاقات المترابطة بين أفراد المجتمع الواحد.
4-
معرفة الجانب الثقافي منهم لكي يستطيع التفاعل معهم.
الوسيلة
الثالثة: فقه التنزيل، وهو المرحلة
الأهم التي يوفق فيها المبلغ بين النص والواقع، وينظر إلى كل منهما، وما ينتج عن
التحامهما من تآلف أو تنافر، ويتطلب:
1- ضرورة فهم علاقة النص
بالواقعة المعينة.
2- ضرورة استبصار النتائج
المترتبة على ربط النص بالواقعة.
3- مراعاة كل ما ذكر في فقه
الواقع.
4- مراعاة التدرج في حمل
الناس على دفع المفسدة أو جلب المصلحة؛ حتى لا تكون النتائج عكسية.
ثالثا: غايات
التبليغ
هذه
الغايات هي ثمرات كل ما سبق ذكره، وتنقسم الغايات إلى قسمين كبيرين هما:
القسم
الأول: امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه في الدنيا
والآخرة. وهذا حق الله تعالى، وفيه تفصيل.
القسم
الثاني: ما يرجى من تحقيق الحياة الطيبة للفرد والجماعة في دينهم ودنياهم وآخرتهم،
وهذا حق العباد، وفيه تفصيل.
ثم
الخاتمة
التمهيد
من
البديهي أن التبليغ هو مهمة عظيمة جليلة، يعني إيصال مراد الله تعالى في الناس للناس،
وهو مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما كان الله تعالى ليأخذ أحدا
بذنب إلا بعد التبليغ، كما قال سبحانه: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)[1]. وقال جل شأنه: (فإما
ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)[2].
وهُدى
الله تعالى كتبه المنزلة ورسله وأنبياؤه المبعوثون لهداية البشرية، وخاتمهم سيدنا
محمد ﷺ. ونحن ندرس في كتب التوحيد أن ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام هو:
الصدق والتبليغ والأمانة، يعني الصدق فيما يقولون ويبلغون، وتبليغ ما يوحى به إليهم
على أساس نفع الناس والعمل لإسعادهم في حياتهم، من غير أن يتركوا شيئا لم يبلغوه،
كما قال الحق سبحانه: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما
بلغت رسالاته)[3].
والأمانة في أداء ذلك بلا زيادة ولا نقصان، فينتفي الكذب والكتمان والخيانة في
حقهم عليهم الصلاة والسلام.
ومن هنا
تكتسب هذه المهمة أهميتها باعتبارها نيابة عن الرسول، ﷺ، في تبليغ الوحي للأمة،
بصدق وأمانة واحتساب وإخلاص. وهو أمر صعب عظيم إلا من يسره الله عليه.
وباعتباره
كذلك نيابة عن ولي أمر المسلمين في القيام بهذا الواجب تجاه شعبه وأمته؛ إذ من
المستحيل أن يعلم كل جاهل ويزكي كل مريد، فاستناب الأئمة والعلماء على ذلك. وتجب
النصيحة له في القيام بهذه المهمة التي لا توازيها مهمة أخرى من مهام الإمامة
العظمى، وفق المتفق عليه من الثوابت المحصنة للأمة من أهل الأهواء.
التبليغ
لغة واصطلاحا
التبليغ
لغة هو الإيصال، وكذلك الإبلاغ، إلا أنه يلاحظ في التبليغ الكثرة في المبلغ، بفتح
اللام، والاسم منه البلاغ، ويأتيان بمعنى واحد في القرآن الكريم.
والتبليغ
اصطلاحا هو تبليغ الرسل والأنبياء أو من يقوم مقامهم من العلماء مراد الله تعالى
من وحيه للناس ليعملوا بمقتضاه لصالح معاشهم ومعادهم.
وقد استعمل
القرآن الكريم من مشتقات المادة، الماضي في قوله تعالى: (فما بلغت رسالاته)[4]، والمضارع في غير ما آية
كقوله تعال: (أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون)[5]. وقوله سبحانه: (أبلغكم
رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين)[6]. وقوله جل شأنه: (وأبلغكم
ما أرسلت به)[7].
والأمر في موضع واحد هو قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ). واسم المصدر المعرف في
أحد عشر موضعا؛ منها قوله سبحانه: (ما على الرسول إلا البلاغ)[8]. وبلاغ بصيغة التنكير في
موضعين: (هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا
الألباب)[9]. و(لهم كأنهم يرونها لم
يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ)[10].
وهذه
المواضع كلها في إثبات التبليغ للرسل وحصر مهمتهم فيها دون التوفيق والهداية، فهما
بيد الله تعالى، كما دلت تلك الآيات كلها على حرص الأنبياء والرسل على تبليغ رسائلهم
لأقوامهم وإقامة الحجة بها عليهم مع بذل النصح والإخلاص فيه، مما يدعو القائم
مقامهم إلى الاتصاف بتلك الصفات والبعد عما يشينها أو يبخس رسالة المبلغ أو يشوش
عليها.
وقد أمر
النبي، ﷺ، بالبلاغ عنه في غير ما حديث، كقوله ﷺ: "بلغوا عني ولو آية"[11]. وقوله ﷺ: "نضر الله
امرأً سمع منا مقالة فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع"[12]. وقوله ﷺ، في حجة الوداع:
"فليبلغ الشاهد منكم الغائب"[13].
وقد أدى
الشاهد، وهم الصحابة، رضي الله عنهم، ما عليهم، وبلغوا القرآن والسنة لمن بعدهم،
وتناقلتها الأجيال حتى وصلت إلينا بحمد الله وشكره، ومن شكر تلك النعمة تبليغها
وإيصالها لمن سيأتي من بعدُ من الأجيال أداء للأمانة وتبليغا للرسالة وإسعادا
للبشرية، وخير الناس أنفعهم للناس، ولا شيء أنفع للعباد من تعليمهم أمور دينهم
ودنياهم؛ إذ بذلك ينالون الفوز والفلاح في الدارين.
أركان
التبليغ:
الركن
الأول: المبلغ عنه، وهو الله، تعالى، الذي أوحى إلى نبيه، ﷺ، ما أوحى من القرآن
والسنة ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة، وكفى هذه المهمة فضلا
وشرفا وغاية في الرفعة والشأن أنها تَلَقٍّ من الله تعالى بواسطة الرسول ﷺ ما يفيد
الناس وينفعهم، ولا شيء أسعد للبشرية مما اختاره الله تعالى وارتضاه لهم دينا به
يدينون، كما قال سبحانه: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
دينا)[14].
وكفى
المبلغ شرفا أن يكون مبلغا عن الله تعالى نيابة عن رسول الله ﷺ، وعمن ولاه الله
أمر المسلمين في إصلاح الرعية وإسعادها بثمرات الوحيين من الكتاب والسنة، ولا أعلم
خطة أخرى، على كثرة الخطط، توازي التبليغ أو تقاربها، ومن هنا تستمد خطورتها
وشأنها الجلل، وأن الخطأ فيها ليس كأي خطأ في مجال من المجالات، فكان لا بد لمن
يسر الله له سبيلها أن يتحلى بما هي أهل له من الصفات والشروط التي تتطلبها للنجاح
في أدائها وتحقيق ما تيسر من ثمارها المرجوة للفرد والجماعة، في الدنيا والآخرة.
الركن
الثاني: المبلغ، وهو القائم بأمر التبليغ، وله من الصفات المؤهلة لذلك ما يأتي:
الصفات
الخلقية:
الصفات
الخلقية كثيرة ومتعددة، وهي كلها مهمة وجديرة بالاستحضار في مجال الدعوة؛ لأن
المبلغ عن الله تعالى يجب أن يمثل الكمال قدر المستطاع، لا أن يكون محط النقد
اللاذع لدى كثير من الناس، ويزعم أنه يقدم ميراث النبوة للناس، فهذا لا يستقيم
بحال؛ ولذا نجد النبي، ﷺ، كان أمينا وصادقا وحسن المعاشرة والمصاحبة والمعاملة
وغير ذلك من مكارم الأخلاق قبل أن يكون نبيا، فلما جاءته النبوة لم يستطع أعداؤه
أن يتهموه بشيء كان يفعله قبل البعثة، كما ذكر أبو سفيان في حواره مع هرقل، إذ لم
يستطع أن يجد مناسبة ولا سؤالا يمكن له أن يدخل فيه شيئا ينتقص من قدر الرسول، ﷺ،
وهو في تلك الحال أحوج ما يكون لذلك[15].
وقد ذكرت
خديجة رضي الله عنها جملة من مكارم الأخلاق يوم أخبرها النبي، ﷺ، أنه نزل عليه
الوحي، وخاف على نفسه، فقالت له: "كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل
الرحم، وتحمل الكَلَّ، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق"[16].
فلا بد
إذاً للمبلغ أن يعود إلى نفسه، ويتلمس صفات الداعية والمبلغ عن الله، تعالى، هل
لديه منها ما يكفي ليمنحها للناس، أو هو في أمس الحاجة إلى تصحيح مساره أولا،
ومحاسبة نفسه ثانيا، قبل أن ينصح بذلك غيره.
الإخلاص:
أول هذه
الصفات وأخطرها شأنا الإخلاص:
إن
الحديث عن الإخلاص يدفع إلى ما مدى أثر الإيمان في النفس، وإلى ما مدى القيام
بالعمل الصالح، وهذان العنصران هما الأولان لتحقيق السعادة للنفس، وليعيش صاحبها
الحياة الطيبة الموعودة من الله تعالى، وحينئذ يمكن أن يدعو إلى ما يعيشه ويؤثر به
في الناس، ويشعر الناس بصدقه، وما يعتلج في نفسه من آثار ما يدعو إليه، وهنا تأتي
النتائج التي أشار إليها القرآن الكريم في آيات عدة، منها قوله تعالى: (أو من كان
ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس)[17].
فهذه
الآية صريحة في أن من كان جاهلا، وهو المراد ب"ميتا"، فهداه الله إلى
الإسلام والإيمان، وهو المراد ب"أحييناه"، يجعل الله له بعد ذلك نورا
يمشي به في الناس، وهو نور الإيمان المشع على قلبه ولسانه وجوارحه. فيمنح للناس
نورا يعيشه في قرارة نفسه، والميت لا يستفيد منه الناس ذلك، وعبارة القرآن في
قوله: (يمشي به في الناس) بليغة جدا؛ لأن المؤمن لا يعيش لنفسه، وإنما يعيش للناس،
ويستفيد منه الناس، ويتأكد هذا عندما يكون إماما أو خطيبا أو واعظا، منتصبا للقيام
بمهمة التبليغ في المجتمع.
والإخلاص
في الإيمان والعمل ينتج عنه الإخلاص في التبليغ من إسداء هذا الخير للناس، كما
أسداه له من علمه وفقهه. وقد ناقش المحدثون هذه المسألة، عند حديثهم عن متى يجوز
للمحدث أن يجلس للتحديث، فكانوا يقولون يجلس للحديث إذا صحح النية. ومنهم من قال:
عالجت موضوع النية أربعين سنة وما زلت.
يقول
العراقي في ألفيته:
وصحح
النية للتـــحديـــث واحرص على نشرك
للحديث[18]
وكذلك
يقال: وصحح النية في التبليغ؛ لأن نشر الحديث جزء من التبليغ. وبتصحيح النية تهون
على المبلغ المصاعب والمشاق، ويدرك أن أجره على قدر تعبه، وأن ما يصبو إليه أعظم
مما يقف له حجر عثرة أمامه، وأنه لو هدى الله تعالى رجلا واحدا على يديه لكان خيرا
له من حُمْرِ النعم ومما طلعت عليه الشمس، كما قال النبي ﷺ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك
حمر النعم»[19].
الصفة
الثانية: العمل بما يدعو إليه
يعتبر
عمل المبلغ بما يدعو إليه وإظهاره في الناس على سبيل الاقتداء به من أهم الصفات
التي تؤتي ثمارها المرجوة في الحين، يقول الله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى
الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين)[20].
ربط الله
سبحانه بين الدعوة والعمل الصالح، واعتبر ذلك أحسن القول، وختم الجملة بالاعتزاز
بالانتماء للمسلمين، مما يدل على حب الدين والعمل به والدعوة إليه، وهذا ما يضع له
القبول بين الناس، كما قال تعالى في آية أخرى حكاية عن شعيب عليه السلام: (وما
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا
بالله عليه توكلت وإليه أنيب)[21].
فقد وضعت
الآية الكريمة منهجا للتبليغ والدعوة إلى الله تعالى في نقاط: التبليغ وعدم
المخالفة إلى ما يدعو إليه، وإرادة الإصلاح، وبذل الوسع، والاعتماد في ذلك كله على
الله تعالى، والإنابة إليه، فهو الموفق لمن شاء بما شاء.
وهكذا
تهدي الآيات القرآنية إلى المنهج الصحيح في التبليغ من خلال الجمع بين إخلاص
المبلغ وعمله واعتزازه بدينه الذي يدعو إليه، واعتماده على الله تعالى بعد الأخذ
بالأسباب.
ولا يكون
ممن يحترف التبليغ ليصل بها إلى الدنيا، فذلك هو السحت وأقبح الطرق إلى الكسب؛
لأنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ويكون قابلا لتحريف الدين وانتحاله وتأويله على
حسب ما تقتضيه مصلحته الدنيوية، ويتنقل في فتاواه حسب الطلب، وفي هذا النوع قال
الشاعر:
إذا
انتصبوا للقول قالوا فأحسنوا ولكن حسن القول خالفه الفعل
وذموا
لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعل[22]
الصفة
الثالثة: الزهد
الزهد هو
القناعة والبعد عن الشبهات، والرضى بما قسم الله تعالى، وقيل: هو البعد عن الحرام
وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، إلى غير ذلك من التعاريف للزهد والورع، وهل
هناك فرق بينهما أم لا؟ للعلماء في ذلك أقوال.
يقول
النبي ﷺ: "ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ما في أيدي الناس يحبك
الناس"[23].
والزهد
في الدنيا هو صرفها في طاعة الله تعالى، ولا يعني عدم الاهتمام بها، أو أن ذلك ذم
للكسب الحلال، ومن ذلك قول الحق، سبحانه، في وصف الأنصار: (ولا يجدون في صدورهم
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم
المفلحون)[24].
فالآية
الكريمة بليغة في التعبير عن الزهد حيث قال، جل شأنه: (ولا يجدون في صدورهم حاجة
مما أوتوا)، حتى لو بحثوا في صدورهم لما وجدوا حاجة تمنعهم من الإنفاق والإيثار
على النفس مع الحاجة الحاضرة الملحة، وقصة الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية معروفة
ومشهورة، حيث ذهب بضيف الرسول، ﷺ، وأمر امرأته بتنويم الصبيان وتقديم ما وجد للضيف
وإطفاء القنديل حتى يشبع.
فعلق
النبي ﷺ على فعلهما بقوله: "قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة"[25]، وفي رواية ابن حبان: "لقد
عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة"[26]. وهو رجل من الأنصار يقال
له أبو طلحة. فنزلت الآية السابقة.
وأما
الزهد في ما في أيدي الناس، فمن المعلوم أن الناس مجبولون على كراهية من يسألهم،
ويميلون إلى من لا يسألهم شيئا، كما قال الشاعر:
ولو سُئِل
الناس التراب لأوشكوا إذا هاتوا أن يملوا ويمنعوا[27]
وقال
الآخر:
لا تسألن
بُنَيَّ آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا
تحجب
الله
يغضب إن تركت سؤاله وبُنَيُّ آدم حين يسأل
يغضب[28]
وما أريد
قوله في هذا السياق هو أن التبليغ يحتاج إلى إظهار العفة وعدم الحاجة إلى ما في
أيدي الناس، وذلك ما يعطيه المصداقية الكبيرة التي تجعله يثمر في النفوس ويزيل
منها ما قد يختلجها من الظنون المشككة في صدق المبلغ.
ولذلك
نجد القرآن الكريم في آيات كثيرة يأمر فيه الحق، سبحانه، الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام بقوله: (قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين)[29]. وقال نوح عليه السلام:
(فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين)[30]. وقال أيضا: (ويا قوم لا
أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله)[31]. وقال هود عليه السلام:
(يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون)[32].
وأمر
نبينا محمد ﷺ بقوله تعالى: (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله)[33]. إلى غير من الآيات التي
ينفي فيها المبلغون عن الله تعالى قصد الوصول إلى أموال الناس عن طريق الدعوة،
مبينين أن أجرهم على الله تعالى الذي أرسلهم وأمرهم بالتبليغ.
ومن هنا
جاء النقاش المعروف بين العلماء حول جواز أو عدم جواز أخذ الأجرة على العلم
والدعوة والصلاة والأذان وغير ذلك مما هو مقرر في محله، ورجحوا الجواز إذا كانت
الأجرة من الدولة للقيام بواجب التبليغ الكفائي على التفرغ له وليس على التبليغ، أو
من الجماعة فيما عرف عندنا في المغرب ب"الشرط" الذي يكون بين الإمام
والجماعة، وهذا كله معروف، وإنما المراد بيان أهمية الاتصاف بصفة الزهد والورع
بالنسبة لمن أُهِّل للقيام بواجب التبليغ.
الصفة
الرابعة: الاحتساب
هذا
الصفة هي فرع عن التي قبلها، فإذا كان المبلغ عن الله مطالب بالزهد والورع والعفاف
عن الناس، فإن أجره ولا شك عند الله تعالى، فعليه أن يحتسب عمله وكل ما يقوم به
لله، وينتظر الأجر العظيم والثواب الجزيل المدخر للمبلغين عن الحق سبحانه، والنصوص
في هذا كثيرة في القرآن والسنة، ومنها ما سبق ذكره في مثل قوله تعالى: (إن أجري
إلا على الله).
ومن
فوائد هذه الصفة تسهيل أمر التبليغ على المبلغ، فلا يجد حرجا من ردود أفعال الناس،
ولا يتبرم من تصرفاتهم، ولا يغتم لعدم اكتراثهم؛ لأن دوره ورسالته محصورة في
البيان لهم، وليس عليه هدايتهم، فإذا أدى ما عليه واحتسب أجره عند الله تعالى
انتهت مهمته، والتوفيق بيد الله تعالى.
وعليه،
فلا معنى لليأس من الناس ومن استقامتهم، إنما عليك البلاغ، وقد فعلت، فلا تقطع
التبليغ لقلة الأتباع، ولا تتحسر من عدم الاتباع، وراجع نفسك، فلعل الخلل في طريقة
التبليغ، أو عدم صحة النية عند المبلغ، أو أي سبب آخر يمكن علاجه وتلافيه،
وهذا
بالضبط مبعث خطة تسديد التبليغ التي قام بها العلماء للبحث عن مكامن الخلل في تدين
المجتمع لمعالجتها والرجوع بها إلى عهدتها الأولى في زمن النبوة وعهد الصحابة
الكرام. كما قال الإمام مالم رحمه الله: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح
به أولها".
وبعد
القيام بما يجب من البيان والموعظة الحسنة، فلا عليك، فأمر القلوب بيد الله تعالى،
وهو ولي التوفيق، سبحانه. واعلم أنه يوم القيامة سيبعث نبي من الأنبياء وليس معه
أحد، ونبي معه واحد أو اثنان، وهذا لا يعني أنه ليس حكيما في دعوته وتبليغه، وإنما
لحِكَمٍ يعلمها الله تعالى في تدبير شؤون عباده.
الصفة
الخامسة: الربانية
يقول
الله تعالى: (كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون)[34]. تعددت تفاسير العلماء
لمعنى الربانية هنا، وما المراد منه، ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: "الرباني
الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره"[35]. يعني الذي يأخذ الناس
بالتدرج ويرفق بهم حتى يتعلموا. وهذا يناسب مقام التبليغ. وقيل: الرباني العالم
العامل بعلمه، لقوله: (بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون).
وجماع
الأمر في الربانية أن يكون المبلغ ربانيا في مصدره وربانيا في وسيلته وربانيا في
غايته.
وربانية المصدر
هو أن يأخذ علمه من القرآن والسنة وما نتج عنهما من اجتهاد وفتاوى الصحابة فمن
بعدهم، مع التزام بما التزمت به الأمة في اختياراتها من المذاهب العقدية والفقهية
والسلوكية والنظامية. وبذلك يكون التصور واضحا لدى المبلغ، فيشتغل في إطار الكتاب
والسنة وما أجمعت عليه الأمة، فيكون بانيا لا هادما، ومصلحا لا مفسدا، ونافعا لا
ضارا.
أما
ربانية الوسيلة، فهي أن يتخذ من الوسائل النافعة ما يلزم لتبليغ رسالته، بشرط صحة
تلك الوسائل وكونها مقبولة شرعا، إذ للوسيلة حكم الغاية، من حيث الأحكام الشرعية،
ولا يجوز التوسل بوسيلة محرمة أو ممنوعة إلى أمر واجب أو مطلوب، بحجة: الغاية تبرر
الوسيلة، فليس من شريعة الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، إلا فيما استثني من جواز أكل
الميتة للمضطر وما في حكمه، مما يدخل في باب الحاجيات المفصلة والمبينة في أصول
الفقه.
وأما
ربانية الغاية، فأمرها واضح؛ إذ القصد من التبليغ هو البلاغ عن الله تعالى للناس،
بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، من تصحيح عباداتهم، وتحسين معاملاتهم وسلوكهم، وما
يدفع عنهم المفاسد والمضار، مع رفع الحرج وملازمة التيسير والرفق في ذلك. وبذلك
تتحقق الحياة الطيبة الموعودة للناس في الدنيا والآخرة، ويكون المبلغ قد أدى ما
عليه وبلغ بالمراد غايته.
والرباني
يصل إلى هذه الغاية بقصده الحسن وفعله الجميل وسلوكه المحمود، فيكون داعيا ومبلغا
في كل حركاته وسكناته، وعند كلامه أو صمته، وفي حضوره أو غيبته، والموفق من وفقه
الله تعالى.
الصفة
السادسة: المحبة
لاشك أن
الربانية تؤدي حتما إلى المحبة، فيحب المبلغ للناس ما يحب لنفسه، فيأخذ لصلاحهم
بكل سبب، ويبذل في تقويم اعوجاجهم كل طاقته، ويعلن لهم أنهم يحبهم، ويحب لهم
الخير، وأن قصده في دعوتهم هو إسعادهم في الدنيا والآخرة، ويبين لهم ثمرات ما يدعو
إليه في المعاش والمعاد؛ لأن من طبيعة الإنسان البحث عن الثمرة لما يطلب منه، فإن
بينت له، عمل، وإلا، كسل وبخل. وفي السيرة النبوية من الأقوال والأفعال الدالة على
محبة النبي، ﷺ، لصحابته وأتباعه خاصة، وللناس عامة ما يرشد إلى أهمية المحبة
وإبرازها للناس، ومنها قوله، ﷺ، لمعاذ بن جبل: "يا معاذ، والله إني
لأحبك" فقال: "أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" وأوصى بذلك معاذ الراويَ عنه، وهو عبد الرحمن بن
عسيلة الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الحُبُلِي[36].
ولا شك
أن معاذا رضي الله عنه تأثر بتصريح النبي، ﷺ، له بالمحبة، وأخبر بذلك من بعده،
وعبر له كذلك عن محبته له، كما عبر النبي، ﷺ، فصار هذا الحديث مسلسلا بالتصريح
بالمحبة.
وفي
الحديث: "إذا أحب الرجل أخاه، فليخبره أنه يحبه"[37]. قيل: وجوبا، وقيل ندبا.
فإن كان
هذا مطلوبا في حق كل شخص يحب الآخر، ففي حق المبلغ عن الله آكد وأجدر؛ لأن المحبة مفتاح
القلوب، وأحوج الناس إلى هذا المفتاح المبلغ عن الله تعالى. والمحبة تحمل على
الرفق بالناس ومسح السآمة عليهم، وكسب ثقتهم، وتسهل انقيادهم.
هذه
مجموعة من أمهات الصفات الأخلاقية المهمة في المبلغ، وتركت صفات أخرى كثيرة تندرج
تحت هذه وتنتمي إليها، والله تعالى الموفق للصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الصفات
العلمية:
إذا اتصف
المبلغ بالصفات الأخلاقية التي سبق الحديث عنها، فإنه؛ لينجح في مهمته، لا بد له
من الصفات العلمية التي تجعله على بصيرة في ما يدعو إليه، لقول الله تعالى آمرا
لنبيه ﷺ: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)[38].
وأول هذه
الصفات: المعرفة بالقرآن الكريم
والمراد
بهذه المعرفة الحصول على قدر كاف من الفهم والحفظ لكتاب الله تعالى لأداء مهمة
التبليغ، والناس في ذلك متفاوتون، وليس بالضرورة أن يحيط علما بالقرآن الكريم،
فذلك مطمح تنقطع دونه الآمال؛ لأن القرآن كلام الله تعالى ونهاية غايته عند الله
جل جلاله، (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما
نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم)[39].
وعليه،
فيكفي أن يكون مطلعا على علوم القرآن وأحكامه وناسخه ومنسوخه وما اشتدت الحاجة
إليه لفهم القرآن الكريم فهما كافيا للاقتباس من أنواره الربانية.
الصفة
الثاني: الاطلاع على السنة والسيرة النبوية
الاطلاع
على السنة النبوية والسيرة النبوية بما يكفي كذلك للاستلهام والاسترشاد بهما لفهم المراد
من الشريعة كتابا وسنة، والاطلاع على علوم الحديث وخصوصا الناسخ والمنسوخ كذلك
ومختلف الحديث ومشكله، حتى لا يحرج عند ورود ما يشبه التعارض، لما روي عن علي رضي
الله عنه، أنه مر على قاصٍّ، فقال له: "أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال:
هلكت وأهلكت"[40]. وقال ابن شهاب:
"أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله ﷺ من منسوخه"[41].
وذلك
لأهمية هذا العلم وخطورته، فكم من متعلم اليوم يشهر في الناس أحاديث منسوخة ولا
عمل عليها، ويؤخر أحاديث عمل الناس بها متهما إياهم بعدم المعرفة بالسنة، وهو أجهل
الناس بها، فيخلق بذلك فتنة بين الناس. وشر العلم الغرائب، كما قال الإمام مالك
رحمه الله. ويعني بذلك ما ليس عليه العمل لسبب من الأسباب، يجهلها غير المختص
والمتعمق في الحديث وعلومه.
والحديث
والسيرة منجمان كبيران للفقه بالشريعة، من يقتبس منهما بمقدار، سائرا في ذلك على
منهج السلف، يحصل على علم غزير، ويجد لكثير من مشاكل الناس حلولا منهما؛ إذ الحديث
والسيرة تطبيق عملي للقرآن الكريم، وسلوك الصحابة وتقويم النبي، ﷺ، لهم وتصحيح
تصرفاتهم، في ذلك كله إشارات عديدة وإضاءات مختلفة لحياة الناس اليوم، وإلى أن يرث
الله الأرض ومن عليها.
ولكن
بالشرط الذي ذكرت من قبل، وهو اتباع السلف في الفهم للقرآن والسنة، والاطلاع على
شروح الحديث المختلفة؛ ليجتمع للمبلغ ما فهم العلماء من النصوص النبوية عبر
التاريخ، ويبني فهمه على فهمهم، فيكون متبعا، لا مبتدعا، وبانيا لا هادما.
الصفة
الثالثة: المعرفة الكافية بالفقه
الفقه هو
زبدة القرآن والحديث وسلالة ما يتضمنانه من الأحكام، وغاية ما يسعى إليه الناظر
فيهما، وليس شيئا خارجا عنهما كما يظن أهل الأهواء من الغالين والمنتحلين
والمبطلين، المحرفين للشريعة لخدمة أغراضهم السيئة.
والفقه
بالنسبة للمبلغ يجب أن يكون منضبطا بالمذهب المعتمد في البلد وأصوله التي ينبني
عليها، وما تراكم من المسائل والفتاوى والنوازل عبر القرون، فكل ذلك لا بد أن يكون
مرعيا عند النظر في فقه المسائل المتعلقة بالمعاملات والأعراف والعادات والمصالح
المرسلة، وما جرى به العمل، وغير ذلك من الأمور التي تجب مراعاتها، حتى يتجنب
المبلغ إحداث الفتنة بدعوته وبلاغه،
كما قال
علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله"[42]. وقال ابن مسعود، رضي الله
عنه: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"[43].
وفي ذكر
هذين الأثرين عند البخاري ومسلم في بداية صحيحيهما دليل على أنه لا ينبغي لأحد أن
يحدث بكل ما سمع، ولا أن يحدث بالمتشابه الذي لا تدركه عقول العامة؛ إن من الحديث
ما يسرد ويفوض أمر معناه لله تعالى، إذ هو من المتشابه المنهي عن تتبعه، ومن حاول
إدراكه كان له فتنة وسبب زيغ له، كما قال الحق سبحانه: (هو الذي أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في
العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولوا الألباب)[44].
والخروج
عن المذهب وما اعتاده الناس ودرجوا عليه من أسباب الفتنة الكبرى، ولو كان ذلك في
المستحبات التي لا يبطل بها عمل، ولا تنتهك بها حرمة، ولكنها غير مألوفة للناس،
فتحدث فيهم بلبلة وتشويشا لا تحمد عقباهما.
الصفة الرابعة:
المعرفة بأصول الفقه
علم أصول
الفقه هو معيار الفقه وميزانه الذي توزن به أحكامه، ولا بد للمبلغ من القدر الكافي
في هذا العلم حتى يتسنى له الحكم على الأشياء، فيكون مطلعا على الأدلة والدلالات
والأحكام وما تفرع عنها من الفروع المختلفة، ويطلع على الاجتهاد وصفات المجتهد
وشروط الاجتهاد.
ويلحق
بأصول الفقه في الأهمية لدى المبلغ القواعد الفقهية التي تندرج تحتها كثير من
الفروع الفقهية باعتبارها نبراسا يستضاء به في فهم كثير من مقاصد الشريعة التي
تتمحور حولها القواعد الفقهية، كالأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرورة
تقدر بقدرها، والضرر يزال، والحرج مرفوع عن الأمة، وغير ذلك من القواعد التي يمشي
المبلغ في ظلالها لأداء رسالته.
ومن
المهم في الفقه وأصوله معرفة الفرق بين ما يتغير من الأحكام المرتبطة بالحياة
اليومية للناس، وبين ما هو ثابت في كل زمان ومكان. فتكون الفتوى والإرشاد في
المتغير مرتبطة بالعادات والأعراف وما جرى به العمل في البلد، والأحوال المختلفة
بين الحواضر والبوادي، وغير ذلك من الأمور التي تجعل الفتوى والبيان تتغير بتغير الزمان
والمكان والحال؛ إذ الأحكام تدور مع العلة وجودا وعدما.
بينما
الثابت ينقل كما هو؛ إذ لا أثر للزمان والمكان فيه، كأحكام الوضوء والصلاة والصيام
وشبه ذلك.
ويستثنى
مما تقدم الفتوى في الشأن العام، وهو ما له أثر على مستوى الجماعة أو الأمة في وطن
واحد، فأمرها موكول لمن لهم الاختصاص في ذلك، وهم هيئة الإفتاء بالمجلس العلمي
الأعلى، فهم وحدهم من يبث في قضايا الشأن العام، حسما لمادة الخلاف وحفاظا على
الأمن الروحي للأمة، باعتبارهم نوابا عن أمير المومنين الذي يرفع حكمه الخلاف في
مثل تلك القضايا.
الصفة
الخامسة: المعرفة باللغة العربية
اللغة
العربية هي الوسيلة لكل ما تقدم من العلم بالكتاب والسنة والفقه والأصول، وهي الباب
الذي يلج منه المتعامل مع القرآن والسنة، ولا سبيل غيرها.
وللغة
العربية علوم مختلفة من نحو وجمل وصرف وبلاغة وغير ذلك، وكلها مهمة بالنسبة للمبلغ
حتى يستطيع النظر والفهم في كتاب الله تعالى، فالجاهل بهذه العلوم لا حق له في
التصدي للقول عن الله وعن رسوله؛ إذ لا يملك لذلك أدواته المطلوبة.
ويتبع
للغة ومركزيتها في التبليغ المعرفة بالدلالات والاصطلاحات التي تتغير باستمرار،
فاكتساب اللغة معجما وأبنية وصرفا وبلاغة لا يكفي لتوظيفها في مخاطبة الناس، ما لم
تعش معهم، وتعرف اصطلاحاتهم في الكلام وسَنَنِهم في التخاطب، فكثيرا ما يفسد سوء
التعبير المعنى الصحيح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: "وكم من مريد للخير
لم يصبه"[45].
وقال الشاعر:
في زخرف
القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء
تعبير
تقول هذا
مجاج النحل تمدحه وإن تشأ، قلت: ذا قيء الزنابير
مدحا وذما
وما جاوزتَ وصفهما حسن البيان يُري الظلماء كالنور[46]
فلتبليغ
معنى ما من المعاني، لا بد من وضعه في قالب لغوي مفهوم لدى المخاطبين بدون عناء، ولا
بد من تجنب التقعر في الكلام وتعمد غريب اللغة فيه؛ لأن ذلك لا يفيد ولا يصل به
المبلغ إلى المراد. وكثيرا ما يركب المتكلم في الشرع هذا المركب الصعب، ولم يجن من
ورائه إلا العناء، ولم يستفد منه المخاطبون شيئا يذكر.
والدعوة
مبنية على التيسير، وأول خطوات التيسير تيسير الفهم على الناس قبل مطالبتهم
بالتطبيق والعمل بمقتضى الكلام.
الصفة
السادسة: المعرفة بالسير والآداب
لكي
يتسنم المبلغ ذروة البلاغة في البلاغ، لا بد له من الاقتباس من سير الأولين بدءا
بسيرة الرسول، ﷺ، وسير الصحابة والتابعين، رضي الله عنهم، فمن بعدهم، والأخذ من
آدابهم والتحلي بسلوكهم والاقتداء بهم في فهم الشريعة؛ إذ الفهم فهمهم؛ والفقه
فقههم، وما رأوا حسنا فهو عند الله حسن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
والوِرْد
من معين السير يساعد كثيرا على التبليغ وفهم أساليبه المختلفة والمفيدة، ويكسب
لصاحبه نفسا طويلا في الوصول إلى المراد اقتداء بالسلف الصالح في صبرهم وتحملهم في
طريق الدعوة وعدم استعجالهم لقط النتائج، فالمبلغ ليس عليه إلا البلاغ، والنتائج
منوطة بمشيئة الله تعالى ومقاديره التي لم يطلع عليها أحدا من خلقه. يقول الله
تعالى لنبيه محمد، ﷺ: (وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ
وعلينا الحساب)[47].
فهذه
مجموعة من المعارف والعلوم لا بد للمبلغ من التسلح بها لكي يؤدي رسالته على أحسن
وجه وأكمله. ولا يتأتى له ذلك إلا إذا كانت مقرونة بمجموعة أخرى من الصفات
المهارية التي تتطلب منه الجمع بين فقه النص وفقه الواقع وفقه التنزيل، وهو ما
سيأتي ذكره أدناه.
الصفات
المهارية للمبلغ
يقصد
بالصفات المهارية ما يلزم المبلغ معرفته لكي يكون قادرا على إيصال المعلومة إلى المستفيد
إيصالا مفيدا نافعا له في دينه ودنياه، ونختصر ذلك في الصفات الآتية:
الصفة
الأولى: الأخذ عن الشيوخ
مما هو
ضروري للمبلغ أن يكون قد أخذ علمه وفقهه ودعوته عن شيوخه؛ لأن هناك أمورا لا توجد
في بطون الكتب، وإنما تؤخذ من أفواه الرجال وتصرفاتهم وفتاواهم وآدابهم وأخلاقهم؛
ولذلك يحذر العلماء من أخذ القرآن من مصحفي، والحديث من صحفي. يعني الذين أخذوا
العلوم من الكتب بدون مشيخة.
وكم وقع
من الطامات لدى أناس تسلقوا منابر العلم والفتوى ومواقع النشر الإكترونية، فأتوا
بالعجائب والغرائب، وشوشوا على الناس بأباطيلهم التي زينها لهم الشيطان، وزعموا
أنهم هم وحدهم الذين يفهمون القرآن والسنة، وكل الأمة على الضلال. وما ذلك منهم
إلا لولوجهم على الشرع من غير بابه، ولم يثنوا يوما ركبهم بين يدي أربابه، ولم
يسمعوا قول الشاعر الناصح لطلابه:
يظن
الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك
العلوم
وما يدري
الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم
إذا رمت
العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم
وتلتبس
الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم[48]
فلا بد
للكلام في الشرع من شيوخ في العلم والتربية معا ليأخذوا بيد الطالب المريد حتى
يتهذب علما وخلقا، ويقدر على أن يستقل بمجاهدة نفسه وصونها، ثم ينتقل إلى مرحلة
البلاغ والتزكية للآخرين، فينفع الله تعالى به لكونه على المنهج السليم والهدى
المستقيم.
وتاريخ
العلماء مليء بالحديث عن المشيخة وما يستفيده الطالب من شيوخه الذين تربى على
أيديهم، وكم من سنة جلس بين أيديهم لأخذ العلم، وكم من سنة جلس للاقتباس من سمتهم
وهديهم، والقصص والآثار في ذلك كثيرة ومشهورة.
الصفة
الثانية: فقه الواقع
والمراد
بفقه الواقع المعرفة بالواقع الذي يعيشه المبلغ والمبلغ إليه؛ إذ المعرفة بفقه
النص الذي سبق ذكره لا تكفي بدون فقه الواقع، ففقه النص يشبه المعرفة بالأدوية
الموجودة في الصيدلية، ومن الدواء ما يقتل، إذا استعمل في غير محله، ومعرفة الواقع
يشبه المعرفة بالأدواء المختلفة، فلا بد من تشخيص الداء أولا قبل وصف الدواء.
ولفقه الواقع مستويات عدة نذكر منها:
معرفة
واقع الناس الديني والدنيوي
إذا كانت
غاية المبلغ هو تحقيق الحياة الطيبة للناس، وهو كذلك، فإنه لا يصل إلى هذه الغاية
بما لا يعنيهم، ولا بالحديث عن شرق الدنيا أو غربها، أو بما يحرجهم ويزيد أمورهم
تعقيدا، وإنما بما يهمهم ويلمس حياتهم، ويمسح عنهم همومهم، ويرفع الحرج والعنت
عنهم، مصداقا لقول الله تعالى في وصف إمام المبلغين، ﷺ: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم)[49]، وقوله سبحانه: (واعلموا
أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)[50].
فالآيتان
واضحتان في أن الغرض من رسالة الإسلام المراد تبليغها هو رفع العنت عن الناس، يقول
ابن جزي في قوله تعالى: (عزيز عليه ما عنتم): "أي يشق عليه عنتكم، والعنت ما
يضرهم في دينهم أو دنياهم"[51]. وكذلك قوله سبحانه: (لو
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم)؛ إذ يطلب منه بعضهم أمرا في نازلة معينة وفيه
العنت للبعض أو الكل، فكان النبي، ﷺ، لا يطيعهم في ذلك رحمة بهم وشفقة عليهم لما سيترتب
على اتباعهم من المشقة والعنت.
وعليه،
فلا بد لورثة النبي، ﷺ، أن يستحضروا هذه المعاني قصد جلب المنافع للعباد ودفع
المضار عنهم، وأن يختاروا لذلك أيسر السبل وأسهل المسالك، إلى نفوسهم مما يحبب
إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.
فيراعي
مستوياتهم في الفهم وعدمه، والفقر والغنى، وتعلقهم بالدين أو تهاونهم، ويسرهم
وعسرهم، وصحتهم ومرضهم، وغير ذلك من الفروق التي تجب مراعاتها لإعطاء كل واحد منهم
ما يناسب حاله، وما يؤدي إلى إسعاده نفسيا وروحيا وجسديا، فيجد كل مسلم على كل حال
نفسَه داخل الاهتمام الشرعي.
ولو
أخذنا نماذج وأمثلة لهذه المراعاة لكان ذلك مفيدا من خلال السيرة النبوية، كتعامل
النبي، ﷺ، مع الأعرابي الذي بال في المسجد، حيث عامله برفق، ونهى الصحابة عن
إذايته وإزرامه؛ لأنه جاهل بحرمة المسجد، فكان المناسب تعليمه برفق، لا زجره
وضربه، مما أدى به في النهاية إلى أن يقول: "اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم
معنا أحدا". هذه طبيعة الإنسان يحب من أحسن إليه، ويكره من أراد إساءته. فصحح
له النبي ﷺ بقوله: "لقد حجرت واسعا" يريد رحمة الله[52].
على خلاف
الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي ﷺ، فأخبروا بها، فكأنهم تقَالُّوها، فقالوا:
وأين نحن من النبي، ﷺ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا
فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل
النساء، فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله، ﷺ، إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا
وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد،
وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»[53].
يلاحظ
الفرق بين طريقة معالجة حال الثلاثة مقارنة بحال الأعرابي السابق؛ لأن هؤلاء فيهم رغبة
شديدة في تحسين مستوى عبادتهم مما أدى بهم إلى العزم على ترك الدنيا بما فيها،
ومواصلة الصيام والقيام في سائر الأيام، وهذا أمر، وإن كانت النية فيه حسنة، مخالف
لمنهج الشرع الوسط الذي جاءت من أجله الرسل، وسار عليه النبي، ﷺ، ولذلك غلظ فيهم
المقالة، ورفض أن يكون المتشدد على سنته بقوله، ﷺ: "فمن رغب عن سني فليس
مني"، ففيه رفض للغلو والتعمق والإيغال في الدين. بينما رفق بالأعرابي وعلمه
بلطف ورفق، مما أدى إلى فهمه لأدب المسجد بلا معاناة.
وقس على
هذا تجد العلاج النبي، ﷺ، لأحوال الناس مختلفا حسب اختلاف تلك الأحوال.
ثانيا:
معرفة عادات الناس وتقاليدهم
تعود
كثير من الفتاوى والأقضية والمسائل إلى عادات الناس وتقاليدهم وأعرافهم مما يدعو
إلى مراعاتها عند البلاغ لهم كي يصل المبلغ إلى مراده منهم، وهو تحقيق الحياة
الطيبة لهم، وليس المراد هنا مجاملة الناس على حساب الشرع، وإنما المراد كيف
تستطيع إسداء النصح لهم في قالب من الاحترام الذي يشعرهم بأنك تريد لهم الخير،
ولست مجرد ناقد ناقض لأحوالهم، والعوائد محكمة، كما هو معلوم، وكذلك الأعراف وهي
من أصول الفقه التي يرجع إليها في أمور كثيرة غير منصوصة، وربما جرى العمل بخلاف
ظاهر النص إذا اقتصت المصلحة ذلك، والأمثلة معلومة فيما جرى به العمل عند الفقهاء.
ثالثا:
معرفة العلاقات المترابطة بين أفراد المجتمع
مما لا شك فيه أن أفراد المجتمع الواحد تربطهم
علاقات متعددة، فيجب على المبلغ أن يدرك ذلك، ويعلم ما بينهم من تماسك فيقويه، ومن
تنافر فيقلل منه، ويسعى المبلغ لتقليل الفجوات بين الناس، باذلا في ذلك كل نصح
وإرشاد، مستعينا عليهم بما فيهم من الصفات الإيجابية منوها بها، وبما فيهم من
الصفات السلبية فيسترها ولا يذكرها، معالجا لأسباب التنافر والخصام بالحكمة
ونسبتها للشيطان، كما فعل يوسف عليه السلام، على الرغم من كل ما صدر من إخوته حيث
قال: (من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبيني إخوتي)، فنسب الخطأ للشيطان، وهو كذلك،
تأليفا لقلوب إخوته وعدم مؤاخذتهم على ما كان منهم.
فيجب
تجنب التشهير بالناس وبعيوبهم وأخطائهم، ومحاولة إصلاح ذات البين بينهم، وتحبيب
بعضهم لبعض، وإبراز أوجه الاتفاق والتعاون بينهم، وتقليل أوجه الاختلاف، ونشر
البسمة والكلمة الطيبة فيهم، وغير ذلك من الأسباب المساعدة على تأليف قلوب الناس
ونشر المحبة فيهم.
الصفة
الثالثة: معرفة فقه التنزيل
إذا تحقق
المبلغ بكل ما تقدم من الصفات وتزود بالمهارات الكافية لأداء مهمته، لا بد له من
أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من فقه آخر، يسمى فقه التنزيل، وهو ببساطة معرفة
كيفية تنزيل النص على واقع الناس، أو معرفة كيفية ربط الواقعة بالنص. ويسميه
العلماء علم الفتوى وعلم القضاء، تمييزا له عن فقه الفتوى وفقه القضاء الذي هو عبارة
عن حفظ النصوص والكتب المعنية بهاتين الخطتين، فمن لا يحسن تنزيل الأحكام والفتاوى
على واقع الناس، لا ينفعه كثرة محفوظاته من المتون الفقهية المختلفة، فهو إذاً علم
خاص يجمع بين النظر في النص، وما يلمح إليه ويدل عليه نصه ودليله وفحواه، وبين
الواقعة النازلة في الزمان والمكان المحددين، والحال الخاصة بصاحب النازلة فردا
كان أو جماعة.
وذلك لأن
النصوص محدودة ومعروفة، ووقائع الناس لا حصر لها، بل هي متجددة بتجدد الزمان
والمكان والحال، كما قال عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما
أحدثوه من الأمور" وفي رواية "من الفجور"[54].
وليس
المراد بالإحداث هنا تغيير الدين أو الخروج على قواعده وأحكامه، وإنما المراد تغير
الأسباب والعلل التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، وهذا معروف في أصول الفقه، فلا
يحتاج إلى كبير عناء.
فيجب على
المبلغ لكي ينجح في إيصال البلاغ إلى الناس أن يجتهد في مراعاة ما يأتي:
أولا:
ضرورة فهم علاقة النص بالواقعة
من
البديهي أن النصوص محدودة والوقائع لا حصر لها، كما سبق ذكره، ولكن تشتمل النصوص
على ما يعطيها السعة الكافية لتسع وقائع الناس، وتستجيب لحاجاتهم، وهذا من سمة
الشريعة الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان، ومن ذلك الكليات الشرعية ومقاصد الشريعة
الملخصة في دفع المفاسد وجلب المنافع، وقد اجتهد العلماء في استقراء ذلك في نصوص
الشريعة، فوجدوها مطردة ومتواترة في حفظ الضروريات الخمس، وتلبية الحاجيات البشرية
وتحقيق التحسينات المرتبطة بالأحوال والعادات وكل ممارسات الإنسان اليومية، وفهموا
من ذلك أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق هذه الضروريات لتستقيم الحياة، وتستجيب
للحاجيات لرفع الحرج وإيجاد الحلول لمعضلات الوقائع، والتخلق بمكارم الأخلاق
الضامنة لمحاسن العادات وجميل التصرفات.
وبناء
على ذلك استنتجوا أصولا هامة جدا تكون بمثابة الميزان الذي توزن به التصرفات
البشرية، للحفاظ على النظام العام للحياة في إطار الفرد والجماعة، بما يضمن
السيرورة العادية للحياة بدون مشاكل، أو بتقليلها على الأقل، فمن هنا جاءت الأصول
الراعية لهذا النظام كالمصلحة المرسلة، وهي أوسعها، وبقاء الحال على ما هو عليه،
وهو الاستصحاب، ومراعاة الخلاف، المنقذ من واقع محظور، ورفعه يؤدي إلى واقع آخر
محظور، فيرتكب أخف المحظورين ويجبر حاله حفظا للحقوق من الضياع، وسد الذريعة
القاطع لسبيل جائزة مفضية إلى محظور، وأمثلة أخرى كثيرة.
كما جاءت
القواعد كذلك مثل: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، واليقين
لا يزال إلا بيقين، والعادة محكمة، وغيرهما من القواعد الفقهية التي هي مفاتح لحل
مشاكل واقع المجتمع.
والمبلغ
في أمس الحاجة إلى هذه القواعد، وبدونها يفسد من حيث يظن أنه يصلح، ويعمق الأضرار
من حيث يريد تخفيفها، وهذا ما يحدث لدى كثير ممن يأخذ بظواهر النصوص، وينزل نصوصا
نزلت في المشركين على واقع المسلمين، ويكفر ويفسق ويبدع، وهو بالتفسيق والتبديع
والتجريح أولى.
وحين
يأخذ المبلغ بهذه الأصول والقواعد، يسهل عليه فهم مراد الشريعة من النصوص، كما
يسهل عليه البحث عن العلاقة بين النص والواقع، باحثا عن العلل الموجبة للتنزيل أو
عدمه، بعد تخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه في الواقعة المراد حملها على النص
بالقياس.
ولا
يتبادر للذهن أن الكلام هنا يخص المفتي والمجيب عن أسئلة الناس، بل يشمل كل متكلم
في الشرع كيفما كان موقعه خطيبا وواعظا ومرشدا في المسجد أو غيره، فليس كل ما يقال
في مجلس يصلح لمجلس آخر، ولا ما يقال لفئة يصلح لفئة أخرى تخالفها في المستوى
الثقافي والاجتماعي وغير ذلك من الفوارق التي تجب مراعاتها.
وفي
السيرة النبوية من الأمثلة لمراعاة الأحوال الشيء الكثير، وقد نهى القرآن الكريم
عن سب الأصنام، مع الجواز، لما ينتج عنها من سب مقدسات المسلمين، وأحسن النبي ﷺ،
الكلام إلى المشركين رغبة في إسلامهم مع عبوسه على عبد الله بن أم مكثوم، وأحسن
الإنصات لأبي الوليد عتبة بن ربيعة لما عرض عليه أمورا لعله يقبلها أو بعضها ويسكت
عنهم، فكان إنصاته ﷺ، وإنصافه له سببا في إنصات أبي الوليد كذلك حتى سمع منه جزءا
كبيرا من سورة (فصلت) كما هو معلوم ومشهور في كتب السيرة.
ثانيا:
ضرورة استبصار النتائج المتوقعة عند ربط النص بالواقعة.
كلمة
استبصار تعني النظر إلى المآل، وكل كلمة يقوله المبلغ لا بد فيها من النظر إلى ما
ستؤول إليه، إيجابا أو سلبا، وإلا كان يتخبط خبط عشواء، وتنعكس عليه دعوته وتبليغه.
لقد دأب
العلماء أسوة بالرسول ﷺ، على
النظر إلى المآل في ما يترتب على فتاواهم وأقضيتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن
المنكر.
ومراعاة
المآلات من أهم القواعد التي تبنى عليها مقاصد الشريعة، وما تراعيه من جلب المصالح
ودرء المفاسد، وما تحققه من نتائج على مستوى الواقع، وتصل إليه من الغايات. وهو
مبني على الموازنة بين المصالح والمفاسد، ويدخل تحته مراعاة الخلاف واختلاف الفتوى
باختلاف الزمان والمكان والحال، وغير ذلك من الأسباب التي تدفع العالم ليقول قولا
في مناسبة، ويقول خلافه في مناسبة مخالفة، وليس ذلك من تناقضه أو تردده، وإنما من
اجتهاده في تنزيل كل قول مكانا يناسبه، ولذلك نجد للعلماء قولين أو أقوالا في
مسألة واحدة، إلى غير ذلك من الأوجه التي تدعو إلى مراعاة المآل في المسائل
والفتاوى.
ثالثا:
مراعاة كل ما ذكر في فقه الواقع
هذه
المراعاة تابعة للتي قبلها، ولذلك نختصر الكلام فيها بالإحالة على كل ما ذكر في
فقه الواقع، من مراعاة أحوال الناس ومستوياتهم في الفهم والعلم والمعيشة، واختلاف
أحوالهم وأعرافهم، وغير ذلك من أسباب اختلاف الفتوى باختلاف الأزمنة والأمكنة
والأحوال، كما هو مقرر في مظانه.
رابعا:
مراعاة التدرج في حمل الناس على دفع مفسدة أو جلب مصلحة
إن مما
يجب مراعاته وأخذه بعين الاعتبار في التبليغ ليكون سديدا وناجعا، وليبلغ في الناس
غاياته المرضية أخذ الناس بالتدرج في بيان الصواب والحث على اتباعه، وبيان الخطأ
والتنفير من ارتكابه.
ولهذا
الأمر مراتب متعددة أهمها مراعاة مستوى الفهم للمخاطبين، فيحملون على قدر فهمهم
على ما يجب اعتقاده والعمل بمقتضاه، وما يجب أن يتسموا به من الأخلاق الحميدة
والمعاملات الحسنة، وأن يربوا على الخير وحبهم للغير.
فلا
ينبغي أن يحمل العالم الناس على فهم ما يحتاج إلى النظر العلمي والنقاش العقدي والمسائل
الفقهية المختلفة، إذ بذلك يتيهون ولا يحسنون التخلص منه بشيء، بل يشكون في صحة
عملهم واعتقادهم، فيقعون فيما منه فروا.
كما فعل
بعض من لم يشم أنفه رائحة الفقه، ونصب نفسه معلما للناس من غير أن يكون هو قد
تعلم، ويطالبهم بالدليل في كل شاذة أو فاذة، زاعما أن هذا هو المنهج السليم في
اتباع السنة واجتناب البدعة، فكان هو بدعا في سلوكه هذا مخالفا لمنهج السلف في عدم
إدخال الناس في أتون الخلاف.
ومن
مراعاة التدرج كذلك أن يسلك العالم سبيل الإقناع فيما يدعو إليه مبينا فضله وأثره
في حياة الناس، وأنهم أقرب إلى الحياة الطيبة إن هم ربطوا بين حق الله تعالى وحق
العباد، وأن عاداتهم ستصبح عبادة بمجرد إخلاص النية فيها، وأن عباداتهم كفيلة
بتحليتهم بالأخلاق الحميدة، كما بين ذلك القرآن الكريم، فالصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر، والزكاة زكاة للأنفس والأموال، والصيام جنة من المعاصي في الدنيا ومن
النار في الآخرة، وأن الحج سبيل إلى التجرد من الهوى والنفس الأمارة بالسوء، ومرب
على ترك الجدال والرفث والفسوق، وغير ذلك مما ورد في فضل هذه العبادات وغيرها من
آثار طبية تسمو بالمسلم إلى مرتبة الإحسان، استدامة المراقبة، فيعبد الله كأنه
يراه. فيعيش حياة طيبة ملئها الرضى بالله وعن الله، والقناعة بما قسم الله،
الاستعداد للقاء الله. (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة
ربه أحدا)[55].
وسائل
التبليغ:
إذا تم
التعرف على على أركان التبليغ وما يشترط فيها من الصفات، وخصوصا المبلغ الذي هو محور
التبليغ، ونجاحها أو خفوقها متوقف عليه في الغالب، يأتي الحديث عن وسائل التبليغ،
والمراد بها المنابر والوسائل المتاحة لتبليغ الرسالة من خلالها، وهي متنوعة
ومتعددة، ويأتي في مقدمة هذه الوسائل:
1- خطبة الجمعة.
تعتبر
خطبة الجمعة المنبر الأول والأساس في تبليغ الدعوة، منذ أن أقام النبي ﷺ صلاة الجمعة مع خطبتها في المدينة المنورة في أول يوم
نزل بها، ولأهمتة هذه الوسيلة بادر النبي ﷺ بإقامتها يوم نزوله من قباء في اتجاه قلب المدينة حيث
مسجده الآن، فحان وقت الصلاة وهو في الطريق فصلى بالصحابة المرافقين له
والمستقبلين له صلاة الجمعة وخطب فيها خطبته المشهورة، في ديار بني سالم، حيث بني
المسجد المعروف إلى اليوم بمسجد الجمعة.
وهي
أول جمعة صلاها النبي ﷺ،
بالمدينة المنورة، بل منذ بعثه الله برسالة الإسلام؛ إذ مكة لا يسمح له فيها
بإقامة الشعائر كالأذان والجمعة والعيدين وغير ذلك.
والمقصود
من ذكر أول جمعة في أول يوم نزل فيه النبي ﷺ، استفادة أهمية الجمعة وما تقدمه للمجتمع من التلاوة
والتزكية والتعليم، وما يتفرع عن هذه الثلاث من أمور العقيدة والعبادة والمعاملات
والأخلاق، ومن خلالها تعلم الصحابة رضي الله عنهم دينهم، في وقت وجيز لا يتجاوز
عشر سنوات، فكان هداة مهديين، فتحوا الدنيا وكانوا أنموذجا في التخلي والتحلي،
وتحلية غيرهم من التابعين الذين تربوا على أيديهم. فتخلصوا من الكفر والشرك
بأنواعه المختلفة، فلا عبادة للأصنام بعد، ولا رياء ولا أنانية ولا كبر ولا يحملون
في نفوسهم شحا ولا بخلا ولو كان بهم خصاصة.
وليس
ببعيد على من أراد أن يصلح حاله وحال غيره إذا صحت عزيمته، وأخذ بما أخذوا به من
الجد والتجرد لفعل الخير من خلال صدق الإيمان والعمل الصالح.
وخطبة
الجمعة عظيمة الشأن جديرة بالتقديس والاحترام؛ لأنها ميراث النبي ﷺ، الذي ورثه عنه العلماء، ونيابة عن أمير المومنين، في
تفقيه الأمة وترشيدها وتعليمها أمور دينها، ولذا لا يجوز لأحد أن يعترض على الإمام
وهو يخطب، بل لا يجوز الكلام وما في حكمه، وإنما الإنصات التام والسكون الكامل
لجميع الجوارح؛ لتقلي أمر الله ونهيه من الخطيب لكي تعمل به ابتداء من ساعتك التي
سمعته فيها، وتتزود منها إلى الجمعة الأخرى.
وعليه،
فيجب على الخطيب أن يقدر هذه المسئولية حق قدرها، وأن يعيرها من الاهتمام ما تستحق
من الأمور الآتية:
-
الإخلاص فيها لله تعالى؛ بحيث يكون القصد أداء الرسالة
على أحسن وجه وأكمله.
-
أن تكون الخطبة صحيحة من حيث مضامينها المنبثقة من
الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من هذه الأمة. فلا مجال فيها لتضييع الوقت بما لا
يصح ثبوتا ومعنى، ولا مجال فيها للانشغال بالقيل والقال وشغل الناس بما حدث أو
يحدث في شرق الدنيا أو غربها، وإنما يحصر الخطيب مهمته في ينفع الناس ويعود عليهم
بعظيم العائدة في دنياهم وأخراهم حتى يعيشوا حياة طيبة بما يتلقونه من النصائح
والتعاليم والمواعظ.
-
أن تكون الخطبة سالمة من التشويش والتشهير والإشهار،
فالمسجد ليس مجال للحزبية والفئوية والعرقية، فلا يجوز تسخير الخطبة لمدح فئة أو
ذم أخرى، وإنما لنصح الجميع بالتمسك بما أمر الله به ورسوله. واجتناب ما نهى عنه.
-
أن يكون الخطيب حاملا لهم الخطبة طيلة أسبوع لأنه مسئول
عما يلقيه على الناس أمام الله تعالى وأمام الناس، فليتق الله تعالى في خلقه.
وهذه فقط بعض النقاط المساعدة على نجاح
الخطيب في خطبته، وهناك نقاط أخرى تندرج في ما تقدم.
2- الموعظة في المسجد أو في أماكن
مختلفة
الموعظة
شأنها شأن الخطبة من حيث المضمون والمطلوب، إلا أنها أخف من حيث الشكل والأداء،
فالموعظة هي ترغيب وترهيب حسب ما يقتضه المقام، مع مراعاة الناس وأخذهم بالتيسير
وتسهيل الصعاب عليهم، كما قال النبي ﷺ: "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تُبَغِّض
إلى نفسك عبادةَ ربك فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى"[56].
فالمبلغ
عن رب العالمين لا بد أن يتسم بالإخلاص والصدق والنصح والصبر، وعدم استعجال
النتائج، وعدم تأييس الناس وتقنيطهم وعدم حملهم على الدين بالمرة؛ لأنه إذا أراد
أن يحملهم على الحق بالمرة تركوه بالمرة.
وفي
حلقات الوعظ يستطيع الواعظ أن يبين ويشرح
ويسأل ويجيب ويناقش في حدود المعقول، لا أن يفتح المجال للمرتابين والمشككين
وأدعياء المعرفة أن يشوشوا على مجلسه، فلا بد أن يحافظ على هيبة الدرس الديني
ليستفيد الناس ويضيفوا إلى معارفهم المزيد لا أن يزدادوا ارتيابا فيما هم عليه.
والدرس
الوعظي قد يكون في المسجد أو في بيت من بيوت الناس أو في أي مكان يراه الواعظ
مناسبا لموعظته. كما كان النبي ﷺ يفعل
حيث يغتنم كل فرصة سانحة لتوجيه الناس وتقديم موعظة هادفة لهم. ومن خلال ذلك تعلم
الصاحبة ولزموا من أجل ذلك رسول الله ﷺ في حركاته وسكناته وسفره وحضره.
فأحصوا أفعاله
وأقواله وتقريراته إحصاء لم يتسن لأحد قبله ولا بعده. ودون العلماء ذلك في دواوين
السنة والسيرة تدوينا كاملا.
3-
الكتابة سواء في الورق أو في المواقع الرقمية
من وسائل
التبليغ الناجعة والمفيدة كذلك الكتابة في مواضيع الدين والدنيا التي تهم الناس في
حياتهم اليومية، فالكتاب خالد ويخلد معه الانتفاع به ويسهل تنقله أكثر من تنقل
صاحبه، ولذلك أقسم الله تعالى بالقلم وما يسطر به من العلوم والمعارف في قوله
سبحانه: (ن والقلم وما يسطرون)[57].
واعتنى
السلف الصالح بكتابة العلم بدءا بكتابة المصحف الشريف والسنة النبوية وما يخدمهما
من العلوم المختلفة.
ولا توجد
أمة تملك من التراث المكتوب عبر ا أجيال ما تملكه أمة الإسلام التي فجرت على الناس
أنهار المعارف في مختلف الفنون.
ولذا
كانت الكتابة من أهم وسائل الدعوة والتبليغ عن الله تعالى وعن رسوله سيدنا محمد ﷺ.
ومما
استجد في حياة الناس اليوم ويجب استغلاله أحسن استغلال الكتابة الرقمية في المواقع
الإكترونية، فهذه المواقع مفروضة على المجتمع المسلم كأي مجتمع آخر على وجه،
وداخلة إلى كل بيت من غير استئذان، فلا مناص منها، وعليه فيجب استغلالها لصالح
دعوة الإسلام، ولتكن من بين الوسائل التي يعتمدها الدعاة والمبلغون عن الله تعالى،
مع الحذر مما يأتي منها أو مما يكتب المبلغ فيها، فلا بد من استحضار القاعدة
الذهبية التي قالها علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن
يكذب الله ورسوله"[58]، وقال ابن مسعود، رضي الله
عنه: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"[59].
فهذان
الأثران من الصحابيين الجليلين قاعدة ذهبية لكل من تصدر للتبليغ والدعوة إلى الله
تعالى، في مراعاة أحوال المخاطبين المختلفة.
ولهذا يشترط
أن تكون الكتابة بكل أنواعها وأشكالها رصينة مضبوطة بالضوابط التي تنضبط بها
الخطبة والموعظة، ولا ينسى الكاتب نفسه فيحلق سماء الغربة والعزلة بعيدا عن
المجتمع وهمومه، فيبهم أكثر مما يفهم، ويشدد أكثر مما ييسر، فالواعظ والخطيب
والكاتب وغيرهم ممن يتكلمون في مجال الدين لا يتكلمون مع أنفسهم وبما هم به
مقتنعون، وإنما يتكلمون مع الناس وما هم في حاجة إليه، في إطار ثوابتهم وأعرافهم
وعاداتهم وأحوالهم.
فإن
راعوا هذه الخصوصيات نجحوا وبلغوا بالتبليغ غايته، وإلا، يصدق فيهم المثل العربي:
"أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"
فالعبرة
بالأثر وبالوسائل التي تحدثه، وخصوصا الأثر الذي تبحث عنه خطة تسديد التبليغ الذي هو
الاستقامة والتدين السليم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وتقليل الكلفة على الناس
ورفع الحرج والعنت عنهم، كما قال الله تعالى عن نبيه ﷺ، سيد المبلغين: (لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما
عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم)[60].
فإذا
تحققت هذه النقاط، فقد آتت الجهود الطيبة أكلها، وسعد الناس بها وعاشوا حياة طيبة
كما وعدهم الله تعالى بها. بكل اطمئنان وسكينة وسهولة ويسر. وما ذلك على الله
بعزيز إذا توفرت الإرادات وصحت العزائم وخلصت النيات.
4-
الكلمة الطيبة في مجلس أو لقاء ما في مكان ما
الكلمة
الطيبة صدقة كما قال النبي ﷺ، ولذلك
تعتبر الكلمة الطيبة من أهم وسائل الدعوة وأسهلها وأكثرها انتشارا، ولذلك نجد
النبي ﷺ، لا
يترك فرصة سانحة إلا وأرسل فيها كلمة أو كلمتين، وكانت كلماته ﷺ هادفة وموجزة ومختصرة.
فلو
تتبعنا معظم أحاديث رسول الله ﷺ،
ومناسباتها وأسباب ورودها لوجدناها قيلت في مناسبات عدة تجمع بين الحضر والسفر
والخاص والعام والرجال والنساء والأطفال وغيرهم من شرائح المجتمع المدني.
وهذا ما
يدعو المبلغ عن الله إلى استحضار الدعوة في كل مكان وبلسان الحال قبل المقال،
وتوخي الحكمة وإصابة الحق فيما يصدر منه من قول أو فعل أو حال.
وغير ما
ذكر من الوسائل المختلفة في تبليغ الرسالة للغير. وإنما ذكرت أهمها وأشهرها
وأكثرها دورانا في حياة الناس.
وأعود
وأؤكد فأقول: لا بد لكل هذه الوسائل أن تكون مؤطرة بالثوابت الدينية والوطنية
للبلاد من أجل البناء ومساعدة الناس على الانخراط في مشروع العلماء الممثل في خطة
تسديد التبليغ والمحافظة على أمنهم الروحي وسلمهم الاجتماعي وتخفيف كلف الحياة
عنهم بإقناعهم بالاستغناء عما يضرهم وعما لا يفيدهم وما لا يعنيهم.
غايات
التبليغ:
غايات
التبليغ هي الثمار المرجوة من كل ما تقدم ذكره، ويمكن تقسيم هذه الغايات إلى قسمين
كبيرين:
القسم
الأول: امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه ابتغاء مرضاته، وجزيل عطائه في الدنيا
والآخرة
القسم
الثاني: ما يرجى من تحقيق الحياة الطيبة للناس كما وعد بها الحق سبحانه وتعالى
بشرطيها الإيمان والعمل الصالح.
وفي يأتي
تفصيل ذلك وبيانه بإذن الله تعالى:
القسم
الأول من غايات التبليغ: ابتغاء مرضاة الله تعالى
مما هو
معلوم من الدين ضرورة أن الله تعالى خلقنا لعبادته، كما قال جل في علاه: (وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون)[61].
وعلى هذا
الأساس ابتعث رسله وأنبياءه، وأنزل كتبه ورسائله، كل ذلك هدى للناس وبينات من
الهدى والفرقان؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة.
وهذا هو
الدين المشار إليه في قوله تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)[62].
وهو
الدين الإسلامي المرضي عند الله تعالى كما قال سبحانه: (إن الدين عند الله
الإسلام)[63]،
وقال جل شأنه: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من
الخاسرين)[64].
وأصوله
في المعتقدات والمعاملات والأخلاق لا تختلف، وإنما الاختلاف في الشرائع التي راعى
فيها الحق سبحانه أحوال عباده، رفقا بهم ورعاية لمصالحهم، كما قال سبحانه: (لكل
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)[65].
ولا يدل
ذلك على البداء أو الظهور بعد الخفاء؛ وإنما المراد منه التيسير الذي هو سمة
الشرائع السماوية، ومجانبة التعسير الذي يتنافى مع طبيعة البشر.
ولما بعث
الله رسوله محمدا ﷺ، ختم
برسالته الرسالات وبنبوته النبوات، فلا نبي بعده ولا رسالة تنزل بعد القرآن، فكان
هذا منشأ كون القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، وأمينا عليها في أصولها، وناسخا
لما لم يعد صالحا من الشرائع السابقة، ومحافظا على ما هو صالح لكل زمان ومكان.
كما كان كذلك
منشأً لشمولية رسالة القرآن لجميع مناحي حياة الناس، ولجميع أنواعهم مع اختلاف
الأجناس والأعراق والألوان، واختار الله تعالى لهذه الرسالة اللغة العربية لتكون
وعاء خاتمة الرسائل السماوية، وبيانا لها مع ما تضمنته من الإعجاز الذي لا يوجد في
غيرها من اللغات، مع تمام البيان وكمال الوضوح.
فقام
النبي ﷺ من هذا
المنطلق الشامل الجامع لتبليغ رسالته في تحقيق العبودية لله تعالى، وتحقيق الحياة
الطيبة للناس في حياتهم اليومية، وإصلاح وتسديد تدينهم لكي يؤتي ثماره المرجوة
منه، في انسجام كامل وتوافق تام بين حقوق الله تعالى وحقوق عباده. وتلك هي غايات
التبليغ وأهدافه الكبرى:
الغاية
الأولى: تحقيق التوحيد لله تعالى
لا شك أن
الغاية من الخلق كله هي توحيد الله وتعالى وإفراده بالعبادة، كما نصت عليه الآيات،
وجاءت به الأحاديث، فالكون كله خلقه الله تعالى للإنسان، والإنسان خلقه لعبادته،
كما قال الله تعالى: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون)[66]. وقال جل شأنه: (والأرض
وضعها للأنام)[67].
إذاً
فالغاية التي تنزلت الشرائع من أجلها هي تحقيق العبادة لله تعالى مع الإخلاص فيها،
وهو المراد بالتوحيد؛ توحيده عبادة وتوحيده عبودية.
وعلى هذا
الأساس جاء المبلغون يبلغون، ويراقبون الله تعالى في تبليغهم، من غير خوف ولا طمع،
(الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا)[68].
وعلى هذا
الأساس يجب أن يعمل العلماء في تسديد التبليغ تحقيقا لهذه الغاية الكبرى، والهدف الأسمى،
من أجل تخليص العباد لله تعالى من الشرك الظاهر ومن الشرك الخفي، الذي هو عبادة
النفس والهوى وما يمليه عليهما الشيطان، وهذا النوع من الشرك هو الأخطر لخفائه
ولمجيئه من بين أضلع الإنسان، وما يصاحبه من التزيين، وما يحفه من الشهوات التي
تغطي خطورته وعيوبه.
فالتوحيد
إذا تحقق سهل على المبلغين والمبلغ إليهم أن يحققوا نتائج مرضية في جميع
المستويات، لأنهم بتحرير الإنسان من نفسه، قد أصبحوا قاطعين أشواطا كبيرة في تحقيق
الهدف لصالح الدين والدنيا، وأعطوا للدين معناه الصحيح، وأدركوا أن ممارسته هي
الغاية في تربية الإنسان وتعليمه، حتى يصبح متدينا.
والتدين
هو التخلق بأخلاق الدين في التزام الأمر واجتناب النهي، مع استحضار المراقبة
الدائمة لله تعالى، وصرف كل حركة أو سكون في مرضاته، وهذه هي مرتبة الإحسان؛ كما
قال النبي ﷺ:
"أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"[69].
وهنا
تفنى الأعمار ويتنافس المتنافسون في سباق، متفاوتين في المراتب والدرجات، كل وما
أداه إليه جهده ومجاهدته، وكلا وعد الله الحسنى، (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا وإن الله لمع المحسنين)[70].
الغاية
الثانية: تحقيق مصالح العباد
وهذه
الغاية ليست غاية مستقلة يمكن تحقيقها بعيدا عن الغاية الأولى، وإنما هي فرع عنها
متوقفة عليها، فلا سبيل إلى الوصول إليها إلا عبر الغاية الأولى.
ومن ثم
فلا تنتظر ممن تنكر لله تعالى وعانده في أمره ونهيه أن يحقق العدل بين الناس، وأن
ينصفهم بتحقيق مصالحهم الدنيوية بعيدا عن النظر إلى دار الجزاء والإيمان به، وكل
ما يدعيه الناس من تحقيق العدل والقيام بمصالح الناس بلا إيمان بالله تعالى ولا
التزام بشريعته فهو موهوم، قائم على أساس الخوف من النيل من الجيوب، فالتزم الجميع
ظاهرا، إن كان هناك التزام، فوقف كل فرد في مساحة محددة له محبوسا عن فعل الخير،
مردوعا بالقوانين الزاجرة التي تحيط به من كل جانب.
وكلما
سنحت له الفرصة ليخون ما تردد؛ لأنه لم يكن الوازع من داخله ليحاسبه، وإنما أبيحت
له المخالفات الهدامة، فلا زاجر ولا مانع، فيظن أنه يمارس شيئا اسمه الحرية، في
خرق أعراض الناس وأكل أموالهم بالباطل، وغير ذلك من صنوف الإجرام المشرعنة، إن صح
هذا التعبير.
ولكن في
ظل هذا النوع من العيش هل هناك حياة طيبة؟ هل هناك شيء اسمه الأسرة وحنينها
وعطفها؟ هل هناك شيء اسمه الرحم والبرور بأهلها؟ هل هناك عناية بجوانب مهمة في
الإنسان تحتاج إلى العناية بها مثل روحه ومشاعره وأحاسيسه، وحبه للغير وإيثاره على
نفسه، وسعيه لتحقيق سعادة الآخرين؟
كل شيء
من ذلك لا يوجد، سوى الأنانية المطلقة، والأثرة المطبقة، والأخلاق المصطنعة لتلبية
الشهوات والرغبات الحيوانية في الإنسان.
أما في
التوحيد وتحرير الإنسان من الشبهات والشهوات، فإن الحياة الطيبة تتحقق بكل
أبعادها، وليس في البعد المادي وحده، كما قد يتوهم البعض، وإنما في بحث الإنسان عن
قيمته أولا، وأين تكمن. وعن سعة أفقه الشامل لعالم الغيب وعالم الشهادة، وعن حياته
الممتدة من الدنيا إلى الآخرة، فلا يشعر بالفناء وقربه منه، بل يحس بالحياة
الأبدية قبل أن يصل إليها، ويجني ثمارها في الدنيا عن طريق السعادة التي تملأ قلبه
بالعبودية لله تعالى، وحب إخوانه لله لا لشيء آخر، وإيثاره لهم على نفسه رغبة فيما
عند الله تعالى، لا خوفا من أحد.
وبهذا يعيش
الإنسان المسلم كما ذكرت سورة العصر بين الإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق
والتواصي بالصبر، في حين يعيش غيره في خسران مبين، بين الهلع والجزع والمنع لحقوق
الآخرين، يبني ما ينهدم، ويجمع ما يفنى، ولا ينفذ بصره إلى عالم آخر ليطمع فيه،
ولا يمكن أن يطمئن إلى الخلود هنا؛ لأنه مما لا مطمع فيه، فيضيع في هذه الدنيا
ويتيه، ويحتار في ما يختاره أيذره أم يأتيه.
وغاية
تسديد خطة التبليغ التي قام بها العلماء أداء للواجب المنوط بأعناقهم، ووفاء لولي
الأمر، ونصحا للمومنين، هي إصلاح ما يمكن إصلاحه من تحرير الناس مما هم فيه، عن
طريق ربطهم بالذي خلقهم ورزقهم؛ ليعلموا ما للنفس وما عليها، فيكفوا مؤونة العنت
والحرج المنبعث من الجهل أحيانا، ومن اتباع الهوى أحيانا أخرى.
ولا يكون
ذلك إلا بالعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، من الإيمان المفيد لليقين،
والتفاني في العمل الصالح، والإيثار للغير في إسداء المعروف، ودرء المكروه، وقد
كان الإمام مالك، رحمه الله، يكرر قوله: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح
به أولها"[71].
فهذه
قاعدة عظيمة، وكلمة جامعة من الإمام، رحمه الله تعالى، يجب الاستفادة منها بالبحث
عما صلح به أول هذه الأمة، وسيجد الباحث الجواب في بيان القرآن الكريم وبيان السنة
النبوية ومنهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الملخص في التلاوة والتزكية
والتعليم، مع مراعاة الزمان والمكان والحال، والأخذ بالتيسير والتدرج في سبيل
الإصلاح. كل ذلك في إطار الثوابت الدينية مع اختيارات ا أمة في ما تقتضيه المصلحة
لتدبير الشأن العام.
فإن تم
التركيز على هذه المصادر والمناهج فإنه سيثمر الإخلاص، وهو رأس مال المسلم، ويثمر
العمل الصالح، وهو زاده، وينتج الأخلاق الحميدة، وهي ربحه، وينظر إلى الحياة على
أنها مطية الآخرة، وكل الحركات والسكنات فيها محسوبة ومحاسب عليها، فتنقلب كلها
عبادات، ويصبح التدين منضبطا بضوابط الشرع الحكيم، فيعيش المسلم بذلك حياة طيبة،
كما وعده الحق سبحانه وتعالى بذلك في محكم تنزيله، ويسري على من بجانبه ما يسري
عليه من الطمأنينة والسعادة الدائمة، ويكون من الذين إذا رؤوا ذكر الله، كما جاء
في قول النبي ﷺ:
"ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم الذين إذا رءوا ذكر
الله"[72].
ومن الذين يجعل الله لهم نورا يمشون به في الناس، وتصرفاتهم كشجرة طيبة تؤتي أكلها
كل حين بإذن ربها.
ويصدق
فيهم قول النبي ﷺ:
"عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر،
فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له"[73].
الخاتمة
وفي
الختام أقول: لا شك أن الشروط المذكورة في هذا العرض فيما يتعلق بكل من المبلغ
والمبلغ إليه وطريقة التبليغ، ومراعاة كل ما سبق زمانا ومكانا وحالا، أنها ستنتج
المقصود منها وتبلغ الغاية التي رسمت لها محققة بذلك أمل العلماء في تحقيق الحياة
الطيبة للناس، في ربطهم بالله تعالى إيمانا وإخلاصا ورضى بحكمه في سائر الأحوال،
وفي تحسين علاقاتهم بعضهم ببعض بما يثمر المحبة والمودة والشعور بحاجة الآخر
والسعي في إسعاده ورفع الحرج عنه امتثالا لقول الله تعالى، في بيان مهمة رسوله
المصطفى ﷺ: (لقد
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم)[74].
والحمد
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم في كل بدء وختام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحسن بن
الحسين إد سعيد السكتاني السوسي لطف الله به وبالمسلمين أجمعين.
[1] - الإسراء 15.
[2] - البقرة 38.
[3] - المائدة 67.
[4] - المائدة 67.
[5] - الأعراف 62.
[6] - الأعراف 68.
[7] - الأحقاف 23.
[8] - المائدة 99.
[9] - إبراهيم 52.
[10] - الأحقاف 35.
[11] - صحيح البخاري باب ما
ذكر عن بني إسرائيل، 4/170.
[12] - سنن أبي داود باب فضل
نشر العلم، 3/322. وسنن الترمذي باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، 5/33.
[13] - صحيح البخاري كتاب
العلم باب ليبلغ الشاهد الغائب، 1/33.
[14] - المائدة 3.
[15] - تراجع قصة أبي سفيان
مع هرقل في صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، 1/8.
[16] - صحيح البخاري كتاب
بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ﷺ، 1/7.
[17] - الأنعام 122.
[18] - ألفية العراقي في
علوم الحديث، باب آداب المحدث، 1/154.
[19] - صحيح البخاري كتاب
الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل، 4/60.
[20] - فصلت 33.
[21] - هود 88.
[22] - البيتان لعبد الله بن
همام السلولي التابعي، تاريخ دمشق لابن عساكر، 33/351.
[23] - المستدرك للحاكم،
كتاب الرقاق، 4/455.
[24] - الحشر 9.
[25] - صحيح مسلم باب إكرام
الضيف، 3/1624.
[26] - صحيح ابن حبان، باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الآية نزلت في بني هاشم، 16/255.
[27] - البيت مشهور وغير
منسوب، وهو من شواهد الألفية، ينظر شرح ابن عقيل على الألفية، 1/332.
[28] - البيتان للإمام
الشافعي.
[29] - الأنعام 90.
[30] - يونس 72.
[31] - هود 29.
[32] - هود 51.
[33] - سبأ 47.
[34] - آل عمران 79.
[35] - صحيح البخاري، كتاب
العلم، باب العلم قبل القول والعمل، 1/26.
[36] - سنن أبي داود باب في
الاستغفار 2/631.
[37] - سنن أبي داود، باب
إخبار الرجل الرجل بمحبته، 4/332. والأدب المفرد للبخاري، 1/124.
[38] - يوسف 108.
[39] - لقمان 27
[40] - الاعتبار في الناسخ
والمنسوخ للحازمي ¼.
[41] - منهج النقد في علوم
الحديث، 1/336.
[42] - صحيح البخاري كتاب
العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم، 1/37.
[43] - صحيح مسلم باب النهي
عن الحديث بكل ما سمع، 1/11.
[44] - آل عمران 7.
[45] - سنن الدارمي باب في
كراهية أخذ الرأي 1/234.
[46] - الأبيات لابن الرومي
.
[47] - الرعد 40.
[48] - الأبيات لأبي حيان
النحوي الأندلسي، من نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقري 2/564.
[49] - التوبة 129.
[50] - الحجرات 7.
[51] - التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي، 1/639.
[52] - صحيح البخاري باب
رحمة الناس والبهائم، 8/10. رقم 6010.
[53] - صحيح البخاري كتاب
النكاح باب الترغيب في النكاح، 7/2. رقم 5063.
[54] - الرسالة لابن أبي زيد
القيرواني، باب في الأقضية والشهادات، 1/132.
[55] - الكهف 110.
[56] - شعب الإيمان للبيهقي
باب القصد في العبادة، 3/401.
[57] - القلم 1.
[58] - صحيح البخاري كتاب
العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم، 1/37.
[59] - مقدمة صحيح مسلم
1/11.
[60] - التوبة 128.
[61] - الذاريات 56.
[62] - الشورى 13.
[63] - آل عمران 19.
[64] - آل عمران 85.
[65] - المائدة 48.
[66] - الجاثية 13.
[67] - الرحمن 10.
[68] - الأحزاب
[69] - صحيح البخاري كتاب
الإيمان باب سؤال جبريل النبي ﷺ، عن الإيمان والإسلام والإحسان، 1/19.
[70] - العنكبوت 69.
[71] - الشفا بتعريف حقوق
المصطفى للقاضي عياض القسم الثاني الباب الرابع، الفصل التاسع في حكم زيارة قبره ﷺ، 2/205.
[72] - سنن ابن ماجة باب من
لا يوبه له، 5/236.
[73] - صحيح مسلم كتاب الزهد
والرقاق باب المؤمن أمره كله خير، 4/227.
[74] - التوبة 128.
بسم
الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه
أجمعين.
وبعد،
فصلة بموضوع ورش تسديد التبليغ الذي انتهضت به مؤسسة العلماء بالمجلس العلمي
الأعلى بتوفيق من الله تعالى، وبوعي ومسؤولية بحاجة المجتمع في هذا الوقت أكثر من
أي وقت مضى لحمايته من الفتن وأصحابها، ولإسعاده ليعيش حياة طيبة كما أراده الله
تعالى ووعده بها، ووعده حق، والإيمان بوعده واجب، جاءت هذه الورقات للحديث عن مهمة
التبليغ وأركانها ووسائلها وغاياتها، إسهاما بجهد المقل في هذا الورش الكبير الذي
وفق الله تعالى إليه ونبه عليه.
وليس
بشيء جديد في دعوة الإسلام، ولكن كأنه مغفول عنه ومشغول عنه بالاهتمام بالشكل دون
المضمون كثيرا تارة، وتارة باحتراف المهام الدينية، والنظر إليها على أنها مصدر
رزق ليس إلا. وهاتان النقطتان تفرغان مهمة التبليغ من مضمونها تفريغا، وتبعدانه عن
أداء مهمة التبليغ التي هي وظيفة الرسول ﷺ، والنائب عنه فيها لا بد أن يسلك بها
مسلكها الصحيح، من تشخيص الأدواء النفسية والاجتماعية المختلفة ووصف الدواء الناجع
لها، بتزكيتها بالإيمان حتى تطمئن النفوس إلى ما عند الله تعالى أكثر مما تطمئن
إلى ما تملك بين يديها، وتحليتها بالعمل الصالح بكل ما تعني الكلمة من معنى، وهذا
هو المراد ب"تسديد التبليغ"، حتى يؤتي ثماره المرجوة منه، من
صلاح الفرد والمجتمع، في سائر الأحوال.
وليس العمل
الصالح محصورا في العبادات على أهميتها في موضوع التبليغ وإصلاح الفرد والمجتمع،
بل يمتد معناه إلى كل تصرفات المسلم في جميع مناحي حياته وفق مراد الله تعالى فيه؛
حتى ترتقي عاداته إلى عبادات، فيحقق معنى قوله، ﷺ: "إنما الأعمال
بالنيات". أي كل الأعمال.
وسأتناول
الموضوع بإذن الله تعالى وحسن توفيقه على الشكل الآتي:
تمهيد
وتعريف
أولا: أركان
التبليغ الأربعة:
المبلغ
عنه، وأهمية معرفته والإخلاص له في التبليغ.
المبلغ،
صفاته وشروطه لأداء مهمته على أحسن وجه وأكمله.
البلاغ،
حقيقته ومعالمه وحدوده
المبلغ
إليه، صفاته وشروط التأثير فيه ومراعاة حاجاته وظروفه.
ثانيا: وسائل
التبليغ:
الوسيلة
الأولى: فقه النص الشرعي كتابا
وسنة، ويتطلب:
1- المعرفة باللغة العربية
معرفة كافية لإدراك مرامي النصوص ومغازيها.
2- المعرفية بعلوم القرآن
والسنة وكيفية أخذ الحكم والأحكام منها.
3- المعرفة بالفقه وأصوله
ومناهج العلماء في استنباط الأحكام.
الوسيلة
الثانية: فقه الواقع الذي يعيشه
المبلغ ومعه الفئة المستهدفة بالتبليغ، ويتطلب:
1-
معرفة واقع الناس الديني والدنيوي
2-
معرفة أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم.
3-
معرفة العلاقات المترابطة بين أفراد المجتمع الواحد.
4-
معرفة الجانب الثقافي منهم لكي يستطيع التفاعل معهم.
الوسيلة
الثالثة: فقه التنزيل، وهو المرحلة
الأهم التي يوفق فيها المبلغ بين النص والواقع، وينظر إلى كل منهما، وما ينتج عن
التحامهما من تآلف أو تنافر، ويتطلب:
1- ضرورة فهم علاقة النص
بالواقعة المعينة.
2- ضرورة استبصار النتائج
المترتبة على ربط النص بالواقعة.
3- مراعاة كل ما ذكر في فقه
الواقع.
4- مراعاة التدرج في حمل
الناس على دفع المفسدة أو جلب المصلحة؛ حتى لا تكون النتائج عكسية.
ثالثا: غايات
التبليغ
هذه
الغايات هي ثمرات كل ما سبق ذكره، وتنقسم الغايات إلى قسمين كبيرين هما:
القسم
الأول: امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه في الدنيا
والآخرة. وهذا حق الله تعالى، وفيه تفصيل.
القسم
الثاني: ما يرجى من تحقيق الحياة الطيبة للفرد والجماعة في دينهم ودنياهم وآخرتهم،
وهذا حق العباد، وفيه تفصيل.
ثم الخاتمة
التمهيد
من
البديهي أن التبليغ هو مهمة عظيمة جليلة، يعني إيصال مراد الله تعالى في الناس للناس،
وهو مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما كان الله تعالى ليأخذ أحدا
بذنب إلا بعد التبليغ، كما قال سبحانه: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)[1]. وقال جل شأنه: (فإما
ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)[2].
وهُدى
الله تعالى كتبه المنزلة ورسله وأنبياؤه المبعوثون لهداية البشرية، وخاتمهم سيدنا
محمد ﷺ. ونحن ندرس في كتب التوحيد أن ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام هو:
الصدق والتبليغ والأمانة، يعني الصدق فيما يقولون ويبلغون، وتبليغ ما يوحى به إليهم
على أساس نفع الناس والعمل لإسعادهم في حياتهم، من غير أن يتركوا شيئا لم يبلغوه،
كما قال الحق سبحانه: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما
بلغت رسالاته)[3].
والأمانة في أداء ذلك بلا زيادة ولا نقصان، فينتفي الكذب والكتمان والخيانة في
حقهم عليهم الصلاة والسلام.
ومن هنا
تكتسب هذه المهمة أهميتها باعتبارها نيابة عن الرسول، ﷺ، في تبليغ الوحي للأمة،
بصدق وأمانة واحتساب وإخلاص. وهو أمر صعب عظيم إلا من يسره الله عليه.
وباعتباره
كذلك نيابة عن ولي أمر المسلمين في القيام بهذا الواجب تجاه شعبه وأمته؛ إذ من
المستحيل أن يعلم كل جاهل ويزكي كل مريد، فاستناب الأئمة والعلماء على ذلك. وتجب
النصيحة له في القيام بهذه المهمة التي لا توازيها مهمة أخرى من مهام الإمامة
العظمى، وفق المتفق عليه من الثوابت المحصنة للأمة من أهل الأهواء.
التبليغ
لغة واصطلاحا
التبليغ
لغة هو الإيصال، وكذلك الإبلاغ، إلا أنه يلاحظ في التبليغ الكثرة في المبلغ، بفتح
اللام، والاسم منه البلاغ، ويأتيان بمعنى واحد في القرآن الكريم.
والتبليغ
اصطلاحا هو تبليغ الرسل والأنبياء أو من يقوم مقامهم من العلماء مراد الله تعالى
من وحيه للناس ليعملوا بمقتضاه لصالح معاشهم ومعادهم.
وقد استعمل
القرآن الكريم من مشتقات المادة، الماضي في قوله تعالى: (فما بلغت رسالاته)[4]، والمضارع في غير ما آية
كقوله تعال: (أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون)[5]. وقوله سبحانه: (أبلغكم
رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين)[6]. وقوله جل شأنه: (وأبلغكم
ما أرسلت به)[7].
والأمر في موضع واحد هو قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ). واسم المصدر المعرف في
أحد عشر موضعا؛ منها قوله سبحانه: (ما على الرسول إلا البلاغ)[8]. وبلاغ بصيغة التنكير في
موضعين: (هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا
الألباب)[9]. و(لهم كأنهم يرونها لم
يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ)[10].
وهذه
المواضع كلها في إثبات التبليغ للرسل وحصر مهمتهم فيها دون التوفيق والهداية، فهما
بيد الله تعالى، كما دلت تلك الآيات كلها على حرص الأنبياء والرسل على تبليغ رسائلهم
لأقوامهم وإقامة الحجة بها عليهم مع بذل النصح والإخلاص فيه، مما يدعو القائم
مقامهم إلى الاتصاف بتلك الصفات والبعد عما يشينها أو يبخس رسالة المبلغ أو يشوش
عليها.
وقد أمر
النبي، ﷺ، بالبلاغ عنه في غير ما حديث، كقوله ﷺ: "بلغوا عني ولو آية"[11]. وقوله ﷺ: "نضر الله
امرأً سمع منا مقالة فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع"[12]. وقوله ﷺ، في حجة الوداع:
"فليبلغ الشاهد منكم الغائب"[13].
وقد أدى
الشاهد، وهم الصحابة، رضي الله عنهم، ما عليهم، وبلغوا القرآن والسنة لمن بعدهم،
وتناقلتها الأجيال حتى وصلت إلينا بحمد الله وشكره، ومن شكر تلك النعمة تبليغها
وإيصالها لمن سيأتي من بعدُ من الأجيال أداء للأمانة وتبليغا للرسالة وإسعادا
للبشرية، وخير الناس أنفعهم للناس، ولا شيء أنفع للعباد من تعليمهم أمور دينهم
ودنياهم؛ إذ بذلك ينالون الفوز والفلاح في الدارين.
أركان
التبليغ:
الركن
الأول: المبلغ عنه، وهو الله، تعالى، الذي أوحى إلى نبيه، ﷺ، ما أوحى من القرآن
والسنة ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة، وكفى هذه المهمة فضلا
وشرفا وغاية في الرفعة والشأن أنها تَلَقٍّ من الله تعالى بواسطة الرسول ﷺ ما يفيد
الناس وينفعهم، ولا شيء أسعد للبشرية مما اختاره الله تعالى وارتضاه لهم دينا به
يدينون، كما قال سبحانه: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
دينا)[14].
وكفى
المبلغ شرفا أن يكون مبلغا عن الله تعالى نيابة عن رسول الله ﷺ، وعمن ولاه الله
أمر المسلمين في إصلاح الرعية وإسعادها بثمرات الوحيين من الكتاب والسنة، ولا أعلم
خطة أخرى، على كثرة الخطط، توازي التبليغ أو تقاربها، ومن هنا تستمد خطورتها
وشأنها الجلل، وأن الخطأ فيها ليس كأي خطأ في مجال من المجالات، فكان لا بد لمن
يسر الله له سبيلها أن يتحلى بما هي أهل له من الصفات والشروط التي تتطلبها للنجاح
في أدائها وتحقيق ما تيسر من ثمارها المرجوة للفرد والجماعة، في الدنيا والآخرة.
الركن
الثاني: المبلغ، وهو القائم بأمر التبليغ، وله من الصفات المؤهلة لذلك ما يأتي:
الصفات
الخلقية:
الصفات
الخلقية كثيرة ومتعددة، وهي كلها مهمة وجديرة بالاستحضار في مجال الدعوة؛ لأن
المبلغ عن الله تعالى يجب أن يمثل الكمال قدر المستطاع، لا أن يكون محط النقد
اللاذع لدى كثير من الناس، ويزعم أنه يقدم ميراث النبوة للناس، فهذا لا يستقيم
بحال؛ ولذا نجد النبي، ﷺ، كان أمينا وصادقا وحسن المعاشرة والمصاحبة والمعاملة
وغير ذلك من مكارم الأخلاق قبل أن يكون نبيا، فلما جاءته النبوة لم يستطع أعداؤه
أن يتهموه بشيء كان يفعله قبل البعثة، كما ذكر أبو سفيان في حواره مع هرقل، إذ لم
يستطع أن يجد مناسبة ولا سؤالا يمكن له أن يدخل فيه شيئا ينتقص من قدر الرسول، ﷺ،
وهو في تلك الحال أحوج ما يكون لذلك[15].
وقد ذكرت
خديجة رضي الله عنها جملة من مكارم الأخلاق يوم أخبرها النبي، ﷺ، أنه نزل عليه
الوحي، وخاف على نفسه، فقالت له: "كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل
الرحم، وتحمل الكَلَّ، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق"[16].
فلا بد
إذاً للمبلغ أن يعود إلى نفسه، ويتلمس صفات الداعية والمبلغ عن الله، تعالى، هل
لديه منها ما يكفي ليمنحها للناس، أو هو في أمس الحاجة إلى تصحيح مساره أولا،
ومحاسبة نفسه ثانيا، قبل أن ينصح بذلك غيره.
الإخلاص:
أول هذه
الصفات وأخطرها شأنا الإخلاص:
إن
الحديث عن الإخلاص يدفع إلى ما مدى أثر الإيمان في النفس، وإلى ما مدى القيام
بالعمل الصالح، وهذان العنصران هما الأولان لتحقيق السعادة للنفس، وليعيش صاحبها
الحياة الطيبة الموعودة من الله تعالى، وحينئذ يمكن أن يدعو إلى ما يعيشه ويؤثر به
في الناس، ويشعر الناس بصدقه، وما يعتلج في نفسه من آثار ما يدعو إليه، وهنا تأتي
النتائج التي أشار إليها القرآن الكريم في آيات عدة، منها قوله تعالى: (أو من كان
ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس)[17].
فهذه
الآية صريحة في أن من كان جاهلا، وهو المراد ب"ميتا"، فهداه الله إلى
الإسلام والإيمان، وهو المراد ب"أحييناه"، يجعل الله له بعد ذلك نورا
يمشي به في الناس، وهو نور الإيمان المشع على قلبه ولسانه وجوارحه. فيمنح للناس
نورا يعيشه في قرارة نفسه، والميت لا يستفيد منه الناس ذلك، وعبارة القرآن في
قوله: (يمشي به في الناس) بليغة جدا؛ لأن المؤمن لا يعيش لنفسه، وإنما يعيش للناس،
ويستفيد منه الناس، ويتأكد هذا عندما يكون إماما أو خطيبا أو واعظا، منتصبا للقيام
بمهمة التبليغ في المجتمع.
والإخلاص
في الإيمان والعمل ينتج عنه الإخلاص في التبليغ من إسداء هذا الخير للناس، كما
أسداه له من علمه وفقهه. وقد ناقش المحدثون هذه المسألة، عند حديثهم عن متى يجوز
للمحدث أن يجلس للتحديث، فكانوا يقولون يجلس للحديث إذا صحح النية. ومنهم من قال:
عالجت موضوع النية أربعين سنة وما زلت.
يقول
العراقي في ألفيته:
وصحح
النية للتـــحديـــث واحرص على نشرك
للحديث[18]
وكذلك
يقال: وصحح النية في التبليغ؛ لأن نشر الحديث جزء من التبليغ. وبتصحيح النية تهون
على المبلغ المصاعب والمشاق، ويدرك أن أجره على قدر تعبه، وأن ما يصبو إليه أعظم
مما يقف له حجر عثرة أمامه، وأنه لو هدى الله تعالى رجلا واحدا على يديه لكان خيرا
له من حُمْرِ النعم ومما طلعت عليه الشمس، كما قال النبي ﷺ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك
حمر النعم»[19].
الصفة
الثانية: العمل بما يدعو إليه
يعتبر
عمل المبلغ بما يدعو إليه وإظهاره في الناس على سبيل الاقتداء به من أهم الصفات
التي تؤتي ثمارها المرجوة في الحين، يقول الله تعالى: (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى
الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين)[20].
ربط الله
سبحانه بين الدعوة والعمل الصالح، واعتبر ذلك أحسن القول، وختم الجملة بالاعتزاز
بالانتماء للمسلمين، مما يدل على حب الدين والعمل به والدعوة إليه، وهذا ما يضع له
القبول بين الناس، كما قال تعالى في آية أخرى حكاية عن شعيب عليه السلام: (وما
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا
بالله عليه توكلت وإليه أنيب)[21].
فقد وضعت
الآية الكريمة منهجا للتبليغ والدعوة إلى الله تعالى في نقاط: التبليغ وعدم
المخالفة إلى ما يدعو إليه، وإرادة الإصلاح، وبذل الوسع، والاعتماد في ذلك كله على
الله تعالى، والإنابة إليه، فهو الموفق لمن شاء بما شاء.
وهكذا
تهدي الآيات القرآنية إلى المنهج الصحيح في التبليغ من خلال الجمع بين إخلاص
المبلغ وعمله واعتزازه بدينه الذي يدعو إليه، واعتماده على الله تعالى بعد الأخذ
بالأسباب.
ولا يكون
ممن يحترف التبليغ ليصل بها إلى الدنيا، فذلك هو السحت وأقبح الطرق إلى الكسب؛
لأنه يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ويكون قابلا لتحريف الدين وانتحاله وتأويله على
حسب ما تقتضيه مصلحته الدنيوية، ويتنقل في فتاواه حسب الطلب، وفي هذا النوع قال
الشاعر:
إذا
انتصبوا للقول قالوا فأحسنوا ولكن حسن القول خالفه الفعل
وذموا
لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعل[22]
الصفة
الثالثة: الزهد
الزهد هو
القناعة والبعد عن الشبهات، والرضى بما قسم الله تعالى، وقيل: هو البعد عن الحرام
وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، إلى غير ذلك من التعاريف للزهد والورع، وهل
هناك فرق بينهما أم لا؟ للعلماء في ذلك أقوال.
يقول
النبي ﷺ: "ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ما في أيدي الناس يحبك
الناس"[23].
والزهد
في الدنيا هو صرفها في طاعة الله تعالى، ولا يعني عدم الاهتمام بها، أو أن ذلك ذم
للكسب الحلال، ومن ذلك قول الحق، سبحانه، في وصف الأنصار: (ولا يجدون في صدورهم
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم
المفلحون)[24].
فالآية
الكريمة بليغة في التعبير عن الزهد حيث قال، جل شأنه: (ولا يجدون في صدورهم حاجة
مما أوتوا)، حتى لو بحثوا في صدورهم لما وجدوا حاجة تمنعهم من الإنفاق والإيثار
على النفس مع الحاجة الحاضرة الملحة، وقصة الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية معروفة
ومشهورة، حيث ذهب بضيف الرسول، ﷺ، وأمر امرأته بتنويم الصبيان وتقديم ما وجد للضيف
وإطفاء القنديل حتى يشبع.
فعلق
النبي ﷺ على فعلهما بقوله: "قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة"[25]، وفي رواية ابن حبان: "لقد
عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة"[26]. وهو رجل من الأنصار يقال
له أبو طلحة. فنزلت الآية السابقة.
وأما
الزهد في ما في أيدي الناس، فمن المعلوم أن الناس مجبولون على كراهية من يسألهم،
ويميلون إلى من لا يسألهم شيئا، كما قال الشاعر:
ولو سُئِل
الناس التراب لأوشكوا إذا هاتوا أن يملوا ويمنعوا[27]
وقال
الآخر:
لا تسألن
بُنَيَّ آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا
تحجب
الله
يغضب إن تركت سؤاله وبُنَيُّ آدم حين يسأل
يغضب[28]
وما أريد
قوله في هذا السياق هو أن التبليغ يحتاج إلى إظهار العفة وعدم الحاجة إلى ما في
أيدي الناس، وذلك ما يعطيه المصداقية الكبيرة التي تجعله يثمر في النفوس ويزيل
منها ما قد يختلجها من الظنون المشككة في صدق المبلغ.
ولذلك
نجد القرآن الكريم في آيات كثيرة يأمر فيه الحق، سبحانه، الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام بقوله: (قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين)[29]. وقال نوح عليه السلام:
(فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين)[30]. وقال أيضا: (ويا قوم لا
أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله)[31]. وقال هود عليه السلام:
(يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون)[32].
وأمر
نبينا محمد ﷺ بقوله تعالى: (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله)[33]. إلى غير من الآيات التي
ينفي فيها المبلغون عن الله تعالى قصد الوصول إلى أموال الناس عن طريق الدعوة،
مبينين أن أجرهم على الله تعالى الذي أرسلهم وأمرهم بالتبليغ.
ومن هنا
جاء النقاش المعروف بين العلماء حول جواز أو عدم جواز أخذ الأجرة على العلم
والدعوة والصلاة والأذان وغير ذلك مما هو مقرر في محله، ورجحوا الجواز إذا كانت
الأجرة من الدولة للقيام بواجب التبليغ الكفائي على التفرغ له وليس على التبليغ، أو
من الجماعة فيما عرف عندنا في المغرب ب"الشرط" الذي يكون بين الإمام
والجماعة، وهذا كله معروف، وإنما المراد بيان أهمية الاتصاف بصفة الزهد والورع
بالنسبة لمن أُهِّل للقيام بواجب التبليغ.
الصفة
الرابعة: الاحتساب
هذا
الصفة هي فرع عن التي قبلها، فإذا كان المبلغ عن الله مطالب بالزهد والورع والعفاف
عن الناس، فإن أجره ولا شك عند الله تعالى، فعليه أن يحتسب عمله وكل ما يقوم به
لله، وينتظر الأجر العظيم والثواب الجزيل المدخر للمبلغين عن الحق سبحانه، والنصوص
في هذا كثيرة في القرآن والسنة، ومنها ما سبق ذكره في مثل قوله تعالى: (إن أجري
إلا على الله).
ومن
فوائد هذه الصفة تسهيل أمر التبليغ على المبلغ، فلا يجد حرجا من ردود أفعال الناس،
ولا يتبرم من تصرفاتهم، ولا يغتم لعدم اكتراثهم؛ لأن دوره ورسالته محصورة في
البيان لهم، وليس عليه هدايتهم، فإذا أدى ما عليه واحتسب أجره عند الله تعالى
انتهت مهمته، والتوفيق بيد الله تعالى.
وعليه،
فلا معنى لليأس من الناس ومن استقامتهم، إنما عليك البلاغ، وقد فعلت، فلا تقطع
التبليغ لقلة الأتباع، ولا تتحسر من عدم الاتباع، وراجع نفسك، فلعل الخلل في طريقة
التبليغ، أو عدم صحة النية عند المبلغ، أو أي سبب آخر يمكن علاجه وتلافيه،
وهذا
بالضبط مبعث خطة تسديد التبليغ التي قام بها العلماء للبحث عن مكامن الخلل في تدين
المجتمع لمعالجتها والرجوع بها إلى عهدتها الأولى في زمن النبوة وعهد الصحابة
الكرام. كما قال الإمام مالم رحمه الله: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح
به أولها".
وبعد
القيام بما يجب من البيان والموعظة الحسنة، فلا عليك، فأمر القلوب بيد الله تعالى،
وهو ولي التوفيق، سبحانه. واعلم أنه يوم القيامة سيبعث نبي من الأنبياء وليس معه
أحد، ونبي معه واحد أو اثنان، وهذا لا يعني أنه ليس حكيما في دعوته وتبليغه، وإنما
لحِكَمٍ يعلمها الله تعالى في تدبير شؤون عباده.
الصفة
الخامسة: الربانية
يقول
الله تعالى: (كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون)[34]. تعددت تفاسير العلماء
لمعنى الربانية هنا، وما المراد منه، ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: "الرباني
الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره"[35]. يعني الذي يأخذ الناس
بالتدرج ويرفق بهم حتى يتعلموا. وهذا يناسب مقام التبليغ. وقيل: الرباني العالم
العامل بعلمه، لقوله: (بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون).
وجماع
الأمر في الربانية أن يكون المبلغ ربانيا في مصدره وربانيا في وسيلته وربانيا في
غايته.
وربانية المصدر
هو أن يأخذ علمه من القرآن والسنة وما نتج عنهما من اجتهاد وفتاوى الصحابة فمن
بعدهم، مع التزام بما التزمت به الأمة في اختياراتها من المذاهب العقدية والفقهية
والسلوكية والنظامية. وبذلك يكون التصور واضحا لدى المبلغ، فيشتغل في إطار الكتاب
والسنة وما أجمعت عليه الأمة، فيكون بانيا لا هادما، ومصلحا لا مفسدا، ونافعا لا
ضارا.
أما
ربانية الوسيلة، فهي أن يتخذ من الوسائل النافعة ما يلزم لتبليغ رسالته، بشرط صحة
تلك الوسائل وكونها مقبولة شرعا، إذ للوسيلة حكم الغاية، من حيث الأحكام الشرعية،
ولا يجوز التوسل بوسيلة محرمة أو ممنوعة إلى أمر واجب أو مطلوب، بحجة: الغاية تبرر
الوسيلة، فليس من شريعة الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، إلا فيما استثني من جواز أكل
الميتة للمضطر وما في حكمه، مما يدخل في باب الحاجيات المفصلة والمبينة في أصول
الفقه.
وأما
ربانية الغاية، فأمرها واضح؛ إذ القصد من التبليغ هو البلاغ عن الله تعالى للناس،
بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، من تصحيح عباداتهم، وتحسين معاملاتهم وسلوكهم، وما
يدفع عنهم المفاسد والمضار، مع رفع الحرج وملازمة التيسير والرفق في ذلك. وبذلك
تتحقق الحياة الطيبة الموعودة للناس في الدنيا والآخرة، ويكون المبلغ قد أدى ما
عليه وبلغ بالمراد غايته.
والرباني
يصل إلى هذه الغاية بقصده الحسن وفعله الجميل وسلوكه المحمود، فيكون داعيا ومبلغا
في كل حركاته وسكناته، وعند كلامه أو صمته، وفي حضوره أو غيبته، والموفق من وفقه
الله تعالى.
الصفة
السادسة: المحبة
لاشك أن
الربانية تؤدي حتما إلى المحبة، فيحب المبلغ للناس ما يحب لنفسه، فيأخذ لصلاحهم
بكل سبب، ويبذل في تقويم اعوجاجهم كل طاقته، ويعلن لهم أنهم يحبهم، ويحب لهم
الخير، وأن قصده في دعوتهم هو إسعادهم في الدنيا والآخرة، ويبين لهم ثمرات ما يدعو
إليه في المعاش والمعاد؛ لأن من طبيعة الإنسان البحث عن الثمرة لما يطلب منه، فإن
بينت له، عمل، وإلا، كسل وبخل. وفي السيرة النبوية من الأقوال والأفعال الدالة على
محبة النبي، ﷺ، لصحابته وأتباعه خاصة، وللناس عامة ما يرشد إلى أهمية المحبة
وإبرازها للناس، ومنها قوله، ﷺ، لمعاذ بن جبل: "يا معاذ، والله إني
لأحبك" فقال: "أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" وأوصى بذلك معاذ الراويَ عنه، وهو عبد الرحمن بن
عسيلة الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الحُبُلِي[36].
ولا شك
أن معاذا رضي الله عنه تأثر بتصريح النبي، ﷺ، له بالمحبة، وأخبر بذلك من بعده،
وعبر له كذلك عن محبته له، كما عبر النبي، ﷺ، فصار هذا الحديث مسلسلا بالتصريح
بالمحبة.
وفي
الحديث: "إذا أحب الرجل أخاه، فليخبره أنه يحبه"[37]. قيل: وجوبا، وقيل ندبا.
فإن كان
هذا مطلوبا في حق كل شخص يحب الآخر، ففي حق المبلغ عن الله آكد وأجدر؛ لأن المحبة مفتاح
القلوب، وأحوج الناس إلى هذا المفتاح المبلغ عن الله تعالى. والمحبة تحمل على
الرفق بالناس ومسح السآمة عليهم، وكسب ثقتهم، وتسهل انقيادهم.
هذه
مجموعة من أمهات الصفات الأخلاقية المهمة في المبلغ، وتركت صفات أخرى كثيرة تندرج
تحت هذه وتنتمي إليها، والله تعالى الموفق للصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الصفات
العلمية:
إذا اتصف
المبلغ بالصفات الأخلاقية التي سبق الحديث عنها، فإنه؛ لينجح في مهمته، لا بد له
من الصفات العلمية التي تجعله على بصيرة في ما يدعو إليه، لقول الله تعالى آمرا
لنبيه ﷺ: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)[38].
وأول هذه
الصفات: المعرفة بالقرآن الكريم
والمراد
بهذه المعرفة الحصول على قدر كاف من الفهم والحفظ لكتاب الله تعالى لأداء مهمة
التبليغ، والناس في ذلك متفاوتون، وليس بالضرورة أن يحيط علما بالقرآن الكريم،
فذلك مطمح تنقطع دونه الآمال؛ لأن القرآن كلام الله تعالى ونهاية غايته عند الله
جل جلاله، (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما
نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم)[39].
وعليه،
فيكفي أن يكون مطلعا على علوم القرآن وأحكامه وناسخه ومنسوخه وما اشتدت الحاجة
إليه لفهم القرآن الكريم فهما كافيا للاقتباس من أنواره الربانية.
الصفة
الثاني: الاطلاع على السنة والسيرة النبوية
الاطلاع
على السنة النبوية والسيرة النبوية بما يكفي كذلك للاستلهام والاسترشاد بهما لفهم المراد
من الشريعة كتابا وسنة، والاطلاع على علوم الحديث وخصوصا الناسخ والمنسوخ كذلك
ومختلف الحديث ومشكله، حتى لا يحرج عند ورود ما يشبه التعارض، لما روي عن علي رضي
الله عنه، أنه مر على قاصٍّ، فقال له: "أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال:
هلكت وأهلكت"[40]. وقال ابن شهاب:
"أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله ﷺ من منسوخه"[41].
وذلك
لأهمية هذا العلم وخطورته، فكم من متعلم اليوم يشهر في الناس أحاديث منسوخة ولا
عمل عليها، ويؤخر أحاديث عمل الناس بها متهما إياهم بعدم المعرفة بالسنة، وهو أجهل
الناس بها، فيخلق بذلك فتنة بين الناس. وشر العلم الغرائب، كما قال الإمام مالك
رحمه الله. ويعني بذلك ما ليس عليه العمل لسبب من الأسباب، يجهلها غير المختص
والمتعمق في الحديث وعلومه.
والحديث
والسيرة منجمان كبيران للفقه بالشريعة، من يقتبس منهما بمقدار، سائرا في ذلك على
منهج السلف، يحصل على علم غزير، ويجد لكثير من مشاكل الناس حلولا منهما؛ إذ الحديث
والسيرة تطبيق عملي للقرآن الكريم، وسلوك الصحابة وتقويم النبي، ﷺ، لهم وتصحيح
تصرفاتهم، في ذلك كله إشارات عديدة وإضاءات مختلفة لحياة الناس اليوم، وإلى أن يرث
الله الأرض ومن عليها.
ولكن
بالشرط الذي ذكرت من قبل، وهو اتباع السلف في الفهم للقرآن والسنة، والاطلاع على
شروح الحديث المختلفة؛ ليجتمع للمبلغ ما فهم العلماء من النصوص النبوية عبر
التاريخ، ويبني فهمه على فهمهم، فيكون متبعا، لا مبتدعا، وبانيا لا هادما.
الصفة
الثالثة: المعرفة الكافية بالفقه
الفقه هو
زبدة القرآن والحديث وسلالة ما يتضمنانه من الأحكام، وغاية ما يسعى إليه الناظر
فيهما، وليس شيئا خارجا عنهما كما يظن أهل الأهواء من الغالين والمنتحلين
والمبطلين، المحرفين للشريعة لخدمة أغراضهم السيئة.
والفقه
بالنسبة للمبلغ يجب أن يكون منضبطا بالمذهب المعتمد في البلد وأصوله التي ينبني
عليها، وما تراكم من المسائل والفتاوى والنوازل عبر القرون، فكل ذلك لا بد أن يكون
مرعيا عند النظر في فقه المسائل المتعلقة بالمعاملات والأعراف والعادات والمصالح
المرسلة، وما جرى به العمل، وغير ذلك من الأمور التي تجب مراعاتها، حتى يتجنب
المبلغ إحداث الفتنة بدعوته وبلاغه،
كما قال
علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله"[42]. وقال ابن مسعود، رضي الله
عنه: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"[43].
وفي ذكر
هذين الأثرين عند البخاري ومسلم في بداية صحيحيهما دليل على أنه لا ينبغي لأحد أن
يحدث بكل ما سمع، ولا أن يحدث بالمتشابه الذي لا تدركه عقول العامة؛ إن من الحديث
ما يسرد ويفوض أمر معناه لله تعالى، إذ هو من المتشابه المنهي عن تتبعه، ومن حاول
إدراكه كان له فتنة وسبب زيغ له، كما قال الحق سبحانه: (هو الذي أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في
العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولوا الألباب)[44].
والخروج
عن المذهب وما اعتاده الناس ودرجوا عليه من أسباب الفتنة الكبرى، ولو كان ذلك في
المستحبات التي لا يبطل بها عمل، ولا تنتهك بها حرمة، ولكنها غير مألوفة للناس،
فتحدث فيهم بلبلة وتشويشا لا تحمد عقباهما.
الصفة الرابعة:
المعرفة بأصول الفقه
علم أصول
الفقه هو معيار الفقه وميزانه الذي توزن به أحكامه، ولا بد للمبلغ من القدر الكافي
في هذا العلم حتى يتسنى له الحكم على الأشياء، فيكون مطلعا على الأدلة والدلالات
والأحكام وما تفرع عنها من الفروع المختلفة، ويطلع على الاجتهاد وصفات المجتهد
وشروط الاجتهاد.
ويلحق
بأصول الفقه في الأهمية لدى المبلغ القواعد الفقهية التي تندرج تحتها كثير من
الفروع الفقهية باعتبارها نبراسا يستضاء به في فهم كثير من مقاصد الشريعة التي
تتمحور حولها القواعد الفقهية، كالأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرورة
تقدر بقدرها، والضرر يزال، والحرج مرفوع عن الأمة، وغير ذلك من القواعد التي يمشي
المبلغ في ظلالها لأداء رسالته.
ومن
المهم في الفقه وأصوله معرفة الفرق بين ما يتغير من الأحكام المرتبطة بالحياة
اليومية للناس، وبين ما هو ثابت في كل زمان ومكان. فتكون الفتوى والإرشاد في
المتغير مرتبطة بالعادات والأعراف وما جرى به العمل في البلد، والأحوال المختلفة
بين الحواضر والبوادي، وغير ذلك من الأمور التي تجعل الفتوى والبيان تتغير بتغير الزمان
والمكان والحال؛ إذ الأحكام تدور مع العلة وجودا وعدما.
بينما
الثابت ينقل كما هو؛ إذ لا أثر للزمان والمكان فيه، كأحكام الوضوء والصلاة والصيام
وشبه ذلك.
ويستثنى
مما تقدم الفتوى في الشأن العام، وهو ما له أثر على مستوى الجماعة أو الأمة في وطن
واحد، فأمرها موكول لمن لهم الاختصاص في ذلك، وهم هيئة الإفتاء بالمجلس العلمي
الأعلى، فهم وحدهم من يبث في قضايا الشأن العام، حسما لمادة الخلاف وحفاظا على
الأمن الروحي للأمة، باعتبارهم نوابا عن أمير المومنين الذي يرفع حكمه الخلاف في
مثل تلك القضايا.
الصفة
الخامسة: المعرفة باللغة العربية
اللغة
العربية هي الوسيلة لكل ما تقدم من العلم بالكتاب والسنة والفقه والأصول، وهي الباب
الذي يلج منه المتعامل مع القرآن والسنة، ولا سبيل غيرها.
وللغة
العربية علوم مختلفة من نحو وجمل وصرف وبلاغة وغير ذلك، وكلها مهمة بالنسبة للمبلغ
حتى يستطيع النظر والفهم في كتاب الله تعالى، فالجاهل بهذه العلوم لا حق له في
التصدي للقول عن الله وعن رسوله؛ إذ لا يملك لذلك أدواته المطلوبة.
ويتبع
للغة ومركزيتها في التبليغ المعرفة بالدلالات والاصطلاحات التي تتغير باستمرار،
فاكتساب اللغة معجما وأبنية وصرفا وبلاغة لا يكفي لتوظيفها في مخاطبة الناس، ما لم
تعش معهم، وتعرف اصطلاحاتهم في الكلام وسَنَنِهم في التخاطب، فكثيرا ما يفسد سوء
التعبير المعنى الصحيح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: "وكم من مريد للخير
لم يصبه"[45].
وقال الشاعر:
في زخرف
القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء
تعبير
تقول هذا
مجاج النحل تمدحه وإن تشأ، قلت: ذا قيء الزنابير
مدحا وذما
وما جاوزتَ وصفهما حسن البيان يُري الظلماء كالنور[46]
فلتبليغ
معنى ما من المعاني، لا بد من وضعه في قالب لغوي مفهوم لدى المخاطبين بدون عناء، ولا
بد من تجنب التقعر في الكلام وتعمد غريب اللغة فيه؛ لأن ذلك لا يفيد ولا يصل به
المبلغ إلى المراد. وكثيرا ما يركب المتكلم في الشرع هذا المركب الصعب، ولم يجن من
ورائه إلا العناء، ولم يستفد منه المخاطبون شيئا يذكر.
والدعوة
مبنية على التيسير، وأول خطوات التيسير تيسير الفهم على الناس قبل مطالبتهم
بالتطبيق والعمل بمقتضى الكلام.
الصفة
السادسة: المعرفة بالسير والآداب
لكي
يتسنم المبلغ ذروة البلاغة في البلاغ، لا بد له من الاقتباس من سير الأولين بدءا
بسيرة الرسول، ﷺ، وسير الصحابة والتابعين، رضي الله عنهم، فمن بعدهم، والأخذ من
آدابهم والتحلي بسلوكهم والاقتداء بهم في فهم الشريعة؛ إذ الفهم فهمهم؛ والفقه
فقههم، وما رأوا حسنا فهو عند الله حسن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
والوِرْد
من معين السير يساعد كثيرا على التبليغ وفهم أساليبه المختلفة والمفيدة، ويكسب
لصاحبه نفسا طويلا في الوصول إلى المراد اقتداء بالسلف الصالح في صبرهم وتحملهم في
طريق الدعوة وعدم استعجالهم لقط النتائج، فالمبلغ ليس عليه إلا البلاغ، والنتائج
منوطة بمشيئة الله تعالى ومقاديره التي لم يطلع عليها أحدا من خلقه. يقول الله
تعالى لنبيه محمد، ﷺ: (وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ
وعلينا الحساب)[47].
فهذه
مجموعة من المعارف والعلوم لا بد للمبلغ من التسلح بها لكي يؤدي رسالته على أحسن
وجه وأكمله. ولا يتأتى له ذلك إلا إذا كانت مقرونة بمجموعة أخرى من الصفات
المهارية التي تتطلب منه الجمع بين فقه النص وفقه الواقع وفقه التنزيل، وهو ما
سيأتي ذكره أدناه.
الصفات
المهارية للمبلغ
يقصد
بالصفات المهارية ما يلزم المبلغ معرفته لكي يكون قادرا على إيصال المعلومة إلى المستفيد
إيصالا مفيدا نافعا له في دينه ودنياه، ونختصر ذلك في الصفات الآتية:
الصفة
الأولى: الأخذ عن الشيوخ
مما هو
ضروري للمبلغ أن يكون قد أخذ علمه وفقهه ودعوته عن شيوخه؛ لأن هناك أمورا لا توجد
في بطون الكتب، وإنما تؤخذ من أفواه الرجال وتصرفاتهم وفتاواهم وآدابهم وأخلاقهم؛
ولذلك يحذر العلماء من أخذ القرآن من مصحفي، والحديث من صحفي. يعني الذين أخذوا
العلوم من الكتب بدون مشيخة.
وكم وقع
من الطامات لدى أناس تسلقوا منابر العلم والفتوى ومواقع النشر الإكترونية، فأتوا
بالعجائب والغرائب، وشوشوا على الناس بأباطيلهم التي زينها لهم الشيطان، وزعموا
أنهم هم وحدهم الذين يفهمون القرآن والسنة، وكل الأمة على الضلال. وما ذلك منهم
إلا لولوجهم على الشرع من غير بابه، ولم يثنوا يوما ركبهم بين يدي أربابه، ولم
يسمعوا قول الشاعر الناصح لطلابه:
يظن
الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك
العلوم
وما يدري
الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم
إذا رمت
العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم
وتلتبس
الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم[48]
فلا بد
للكلام في الشرع من شيوخ في العلم والتربية معا ليأخذوا بيد الطالب المريد حتى
يتهذب علما وخلقا، ويقدر على أن يستقل بمجاهدة نفسه وصونها، ثم ينتقل إلى مرحلة
البلاغ والتزكية للآخرين، فينفع الله تعالى به لكونه على المنهج السليم والهدى
المستقيم.
وتاريخ
العلماء مليء بالحديث عن المشيخة وما يستفيده الطالب من شيوخه الذين تربى على
أيديهم، وكم من سنة جلس بين أيديهم لأخذ العلم، وكم من سنة جلس للاقتباس من سمتهم
وهديهم، والقصص والآثار في ذلك كثيرة ومشهورة.
الصفة
الثانية: فقه الواقع
والمراد
بفقه الواقع المعرفة بالواقع الذي يعيشه المبلغ والمبلغ إليه؛ إذ المعرفة بفقه
النص الذي سبق ذكره لا تكفي بدون فقه الواقع، ففقه النص يشبه المعرفة بالأدوية
الموجودة في الصيدلية، ومن الدواء ما يقتل، إذا استعمل في غير محله، ومعرفة الواقع
يشبه المعرفة بالأدواء المختلفة، فلا بد من تشخيص الداء أولا قبل وصف الدواء.
ولفقه الواقع مستويات عدة نذكر منها:
معرفة
واقع الناس الديني والدنيوي
إذا كانت
غاية المبلغ هو تحقيق الحياة الطيبة للناس، وهو كذلك، فإنه لا يصل إلى هذه الغاية
بما لا يعنيهم، ولا بالحديث عن شرق الدنيا أو غربها، أو بما يحرجهم ويزيد أمورهم
تعقيدا، وإنما بما يهمهم ويلمس حياتهم، ويمسح عنهم همومهم، ويرفع الحرج والعنت
عنهم، مصداقا لقول الله تعالى في وصف إمام المبلغين، ﷺ: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم)[49]، وقوله سبحانه: (واعلموا
أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)[50].
فالآيتان
واضحتان في أن الغرض من رسالة الإسلام المراد تبليغها هو رفع العنت عن الناس، يقول
ابن جزي في قوله تعالى: (عزيز عليه ما عنتم): "أي يشق عليه عنتكم، والعنت ما
يضرهم في دينهم أو دنياهم"[51]. وكذلك قوله سبحانه: (لو
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم)؛ إذ يطلب منه بعضهم أمرا في نازلة معينة وفيه
العنت للبعض أو الكل، فكان النبي، ﷺ، لا يطيعهم في ذلك رحمة بهم وشفقة عليهم لما سيترتب
على اتباعهم من المشقة والعنت.
وعليه،
فلا بد لورثة النبي، ﷺ، أن يستحضروا هذه المعاني قصد جلب المنافع للعباد ودفع
المضار عنهم، وأن يختاروا لذلك أيسر السبل وأسهل المسالك، إلى نفوسهم مما يحبب
إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.
فيراعي
مستوياتهم في الفهم وعدمه، والفقر والغنى، وتعلقهم بالدين أو تهاونهم، ويسرهم
وعسرهم، وصحتهم ومرضهم، وغير ذلك من الفروق التي تجب مراعاتها لإعطاء كل واحد منهم
ما يناسب حاله، وما يؤدي إلى إسعاده نفسيا وروحيا وجسديا، فيجد كل مسلم على كل حال
نفسَه داخل الاهتمام الشرعي.
ولو
أخذنا نماذج وأمثلة لهذه المراعاة لكان ذلك مفيدا من خلال السيرة النبوية، كتعامل
النبي، ﷺ، مع الأعرابي الذي بال في المسجد، حيث عامله برفق، ونهى الصحابة عن
إذايته وإزرامه؛ لأنه جاهل بحرمة المسجد، فكان المناسب تعليمه برفق، لا زجره
وضربه، مما أدى به في النهاية إلى أن يقول: "اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم
معنا أحدا". هذه طبيعة الإنسان يحب من أحسن إليه، ويكره من أراد إساءته. فصحح
له النبي ﷺ بقوله: "لقد حجرت واسعا" يريد رحمة الله[52].
على خلاف
الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي ﷺ، فأخبروا بها، فكأنهم تقَالُّوها، فقالوا:
وأين نحن من النبي، ﷺ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا
فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل
النساء، فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله، ﷺ، إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا
وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد،
وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»[53].
يلاحظ
الفرق بين طريقة معالجة حال الثلاثة مقارنة بحال الأعرابي السابق؛ لأن هؤلاء فيهم رغبة
شديدة في تحسين مستوى عبادتهم مما أدى بهم إلى العزم على ترك الدنيا بما فيها،
ومواصلة الصيام والقيام في سائر الأيام، وهذا أمر، وإن كانت النية فيه حسنة، مخالف
لمنهج الشرع الوسط الذي جاءت من أجله الرسل، وسار عليه النبي، ﷺ، ولذلك غلظ فيهم
المقالة، ورفض أن يكون المتشدد على سنته بقوله، ﷺ: "فمن رغب عن سني فليس
مني"، ففيه رفض للغلو والتعمق والإيغال في الدين. بينما رفق بالأعرابي وعلمه
بلطف ورفق، مما أدى إلى فهمه لأدب المسجد بلا معاناة.
وقس على
هذا تجد العلاج النبي، ﷺ، لأحوال الناس مختلفا حسب اختلاف تلك الأحوال.
ثانيا:
معرفة عادات الناس وتقاليدهم
تعود
كثير من الفتاوى والأقضية والمسائل إلى عادات الناس وتقاليدهم وأعرافهم مما يدعو
إلى مراعاتها عند البلاغ لهم كي يصل المبلغ إلى مراده منهم، وهو تحقيق الحياة
الطيبة لهم، وليس المراد هنا مجاملة الناس على حساب الشرع، وإنما المراد كيف
تستطيع إسداء النصح لهم في قالب من الاحترام الذي يشعرهم بأنك تريد لهم الخير،
ولست مجرد ناقد ناقض لأحوالهم، والعوائد محكمة، كما هو معلوم، وكذلك الأعراف وهي
من أصول الفقه التي يرجع إليها في أمور كثيرة غير منصوصة، وربما جرى العمل بخلاف
ظاهر النص إذا اقتصت المصلحة ذلك، والأمثلة معلومة فيما جرى به العمل عند الفقهاء.
ثالثا:
معرفة العلاقات المترابطة بين أفراد المجتمع
مما لا شك فيه أن أفراد المجتمع الواحد تربطهم
علاقات متعددة، فيجب على المبلغ أن يدرك ذلك، ويعلم ما بينهم من تماسك فيقويه، ومن
تنافر فيقلل منه، ويسعى المبلغ لتقليل الفجوات بين الناس، باذلا في ذلك كل نصح
وإرشاد، مستعينا عليهم بما فيهم من الصفات الإيجابية منوها بها، وبما فيهم من
الصفات السلبية فيسترها ولا يذكرها، معالجا لأسباب التنافر والخصام بالحكمة
ونسبتها للشيطان، كما فعل يوسف عليه السلام، على الرغم من كل ما صدر من إخوته حيث
قال: (من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبيني إخوتي)، فنسب الخطأ للشيطان، وهو كذلك،
تأليفا لقلوب إخوته وعدم مؤاخذتهم على ما كان منهم.
فيجب
تجنب التشهير بالناس وبعيوبهم وأخطائهم، ومحاولة إصلاح ذات البين بينهم، وتحبيب
بعضهم لبعض، وإبراز أوجه الاتفاق والتعاون بينهم، وتقليل أوجه الاختلاف، ونشر
البسمة والكلمة الطيبة فيهم، وغير ذلك من الأسباب المساعدة على تأليف قلوب الناس
ونشر المحبة فيهم.
الصفة
الثالثة: معرفة فقه التنزيل
إذا تحقق
المبلغ بكل ما تقدم من الصفات وتزود بالمهارات الكافية لأداء مهمته، لا بد له من
أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من فقه آخر، يسمى فقه التنزيل، وهو ببساطة معرفة
كيفية تنزيل النص على واقع الناس، أو معرفة كيفية ربط الواقعة بالنص. ويسميه
العلماء علم الفتوى وعلم القضاء، تمييزا له عن فقه الفتوى وفقه القضاء الذي هو عبارة
عن حفظ النصوص والكتب المعنية بهاتين الخطتين، فمن لا يحسن تنزيل الأحكام والفتاوى
على واقع الناس، لا ينفعه كثرة محفوظاته من المتون الفقهية المختلفة، فهو إذاً علم
خاص يجمع بين النظر في النص، وما يلمح إليه ويدل عليه نصه ودليله وفحواه، وبين
الواقعة النازلة في الزمان والمكان المحددين، والحال الخاصة بصاحب النازلة فردا
كان أو جماعة.
وذلك لأن
النصوص محدودة ومعروفة، ووقائع الناس لا حصر لها، بل هي متجددة بتجدد الزمان
والمكان والحال، كما قال عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما
أحدثوه من الأمور" وفي رواية "من الفجور"[54].
وليس
المراد بالإحداث هنا تغيير الدين أو الخروج على قواعده وأحكامه، وإنما المراد تغير
الأسباب والعلل التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، وهذا معروف في أصول الفقه، فلا
يحتاج إلى كبير عناء.
فيجب على
المبلغ لكي ينجح في إيصال البلاغ إلى الناس أن يجتهد في مراعاة ما يأتي:
أولا:
ضرورة فهم علاقة النص بالواقعة
من
البديهي أن النصوص محدودة والوقائع لا حصر لها، كما سبق ذكره، ولكن تشتمل النصوص
على ما يعطيها السعة الكافية لتسع وقائع الناس، وتستجيب لحاجاتهم، وهذا من سمة
الشريعة الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان، ومن ذلك الكليات الشرعية ومقاصد الشريعة
الملخصة في دفع المفاسد وجلب المنافع، وقد اجتهد العلماء في استقراء ذلك في نصوص
الشريعة، فوجدوها مطردة ومتواترة في حفظ الضروريات الخمس، وتلبية الحاجيات البشرية
وتحقيق التحسينات المرتبطة بالأحوال والعادات وكل ممارسات الإنسان اليومية، وفهموا
من ذلك أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق هذه الضروريات لتستقيم الحياة، وتستجيب
للحاجيات لرفع الحرج وإيجاد الحلول لمعضلات الوقائع، والتخلق بمكارم الأخلاق
الضامنة لمحاسن العادات وجميل التصرفات.
وبناء
على ذلك استنتجوا أصولا هامة جدا تكون بمثابة الميزان الذي توزن به التصرفات
البشرية، للحفاظ على النظام العام للحياة في إطار الفرد والجماعة، بما يضمن
السيرورة العادية للحياة بدون مشاكل، أو بتقليلها على الأقل، فمن هنا جاءت الأصول
الراعية لهذا النظام كالمصلحة المرسلة، وهي أوسعها، وبقاء الحال على ما هو عليه،
وهو الاستصحاب، ومراعاة الخلاف، المنقذ من واقع محظور، ورفعه يؤدي إلى واقع آخر
محظور، فيرتكب أخف المحظورين ويجبر حاله حفظا للحقوق من الضياع، وسد الذريعة
القاطع لسبيل جائزة مفضية إلى محظور، وأمثلة أخرى كثيرة.
كما جاءت
القواعد كذلك مثل: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، واليقين
لا يزال إلا بيقين، والعادة محكمة، وغيرهما من القواعد الفقهية التي هي مفاتح لحل
مشاكل واقع المجتمع.
والمبلغ
في أمس الحاجة إلى هذه القواعد، وبدونها يفسد من حيث يظن أنه يصلح، ويعمق الأضرار
من حيث يريد تخفيفها، وهذا ما يحدث لدى كثير ممن يأخذ بظواهر النصوص، وينزل نصوصا
نزلت في المشركين على واقع المسلمين، ويكفر ويفسق ويبدع، وهو بالتفسيق والتبديع
والتجريح أولى.
وحين
يأخذ المبلغ بهذه الأصول والقواعد، يسهل عليه فهم مراد الشريعة من النصوص، كما
يسهل عليه البحث عن العلاقة بين النص والواقع، باحثا عن العلل الموجبة للتنزيل أو
عدمه، بعد تخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه في الواقعة المراد حملها على النص
بالقياس.
ولا
يتبادر للذهن أن الكلام هنا يخص المفتي والمجيب عن أسئلة الناس، بل يشمل كل متكلم
في الشرع كيفما كان موقعه خطيبا وواعظا ومرشدا في المسجد أو غيره، فليس كل ما يقال
في مجلس يصلح لمجلس آخر، ولا ما يقال لفئة يصلح لفئة أخرى تخالفها في المستوى
الثقافي والاجتماعي وغير ذلك من الفوارق التي تجب مراعاتها.
وفي
السيرة النبوية من الأمثلة لمراعاة الأحوال الشيء الكثير، وقد نهى القرآن الكريم
عن سب الأصنام، مع الجواز، لما ينتج عنها من سب مقدسات المسلمين، وأحسن النبي ﷺ،
الكلام إلى المشركين رغبة في إسلامهم مع عبوسه على عبد الله بن أم مكثوم، وأحسن
الإنصات لأبي الوليد عتبة بن ربيعة لما عرض عليه أمورا لعله يقبلها أو بعضها ويسكت
عنهم، فكان إنصاته ﷺ، وإنصافه له سببا في إنصات أبي الوليد كذلك حتى سمع منه جزءا
كبيرا من سورة (فصلت) كما هو معلوم ومشهور في كتب السيرة.
ثانيا:
ضرورة استبصار النتائج المتوقعة عند ربط النص بالواقعة.
كلمة
استبصار تعني النظر إلى المآل، وكل كلمة يقوله المبلغ لا بد فيها من النظر إلى ما
ستؤول إليه، إيجابا أو سلبا، وإلا كان يتخبط خبط عشواء، وتنعكس عليه دعوته وتبليغه.
لقد دأب
العلماء أسوة بالرسول ﷺ، على
النظر إلى المآل في ما يترتب على فتاواهم وأقضيتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن
المنكر.
ومراعاة
المآلات من أهم القواعد التي تبنى عليها مقاصد الشريعة، وما تراعيه من جلب المصالح
ودرء المفاسد، وما تحققه من نتائج على مستوى الواقع، وتصل إليه من الغايات. وهو
مبني على الموازنة بين المصالح والمفاسد، ويدخل تحته مراعاة الخلاف واختلاف الفتوى
باختلاف الزمان والمكان والحال، وغير ذلك من الأسباب التي تدفع العالم ليقول قولا
في مناسبة، ويقول خلافه في مناسبة مخالفة، وليس ذلك من تناقضه أو تردده، وإنما من
اجتهاده في تنزيل كل قول مكانا يناسبه، ولذلك نجد للعلماء قولين أو أقوالا في
مسألة واحدة، إلى غير ذلك من الأوجه التي تدعو إلى مراعاة المآل في المسائل
والفتاوى.
ثالثا:
مراعاة كل ما ذكر في فقه الواقع
هذه
المراعاة تابعة للتي قبلها، ولذلك نختصر الكلام فيها بالإحالة على كل ما ذكر في
فقه الواقع، من مراعاة أحوال الناس ومستوياتهم في الفهم والعلم والمعيشة، واختلاف
أحوالهم وأعرافهم، وغير ذلك من أسباب اختلاف الفتوى باختلاف الأزمنة والأمكنة
والأحوال، كما هو مقرر في مظانه.
رابعا:
مراعاة التدرج في حمل الناس على دفع مفسدة أو جلب مصلحة
إن مما
يجب مراعاته وأخذه بعين الاعتبار في التبليغ ليكون سديدا وناجعا، وليبلغ في الناس
غاياته المرضية أخذ الناس بالتدرج في بيان الصواب والحث على اتباعه، وبيان الخطأ
والتنفير من ارتكابه.
ولهذا
الأمر مراتب متعددة أهمها مراعاة مستوى الفهم للمخاطبين، فيحملون على قدر فهمهم
على ما يجب اعتقاده والعمل بمقتضاه، وما يجب أن يتسموا به من الأخلاق الحميدة
والمعاملات الحسنة، وأن يربوا على الخير وحبهم للغير.
فلا
ينبغي أن يحمل العالم الناس على فهم ما يحتاج إلى النظر العلمي والنقاش العقدي والمسائل
الفقهية المختلفة، إذ بذلك يتيهون ولا يحسنون التخلص منه بشيء، بل يشكون في صحة
عملهم واعتقادهم، فيقعون فيما منه فروا.
كما فعل
بعض من لم يشم أنفه رائحة الفقه، ونصب نفسه معلما للناس من غير أن يكون هو قد
تعلم، ويطالبهم بالدليل في كل شاذة أو فاذة، زاعما أن هذا هو المنهج السليم في
اتباع السنة واجتناب البدعة، فكان هو بدعا في سلوكه هذا مخالفا لمنهج السلف في عدم
إدخال الناس في أتون الخلاف.
ومن
مراعاة التدرج كذلك أن يسلك العالم سبيل الإقناع فيما يدعو إليه مبينا فضله وأثره
في حياة الناس، وأنهم أقرب إلى الحياة الطيبة إن هم ربطوا بين حق الله تعالى وحق
العباد، وأن عاداتهم ستصبح عبادة بمجرد إخلاص النية فيها، وأن عباداتهم كفيلة
بتحليتهم بالأخلاق الحميدة، كما بين ذلك القرآن الكريم، فالصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر، والزكاة زكاة للأنفس والأموال، والصيام جنة من المعاصي في الدنيا ومن
النار في الآخرة، وأن الحج سبيل إلى التجرد من الهوى والنفس الأمارة بالسوء، ومرب
على ترك الجدال والرفث والفسوق، وغير ذلك مما ورد في فضل هذه العبادات وغيرها من
آثار طبية تسمو بالمسلم إلى مرتبة الإحسان، استدامة المراقبة، فيعبد الله كأنه
يراه. فيعيش حياة طيبة ملئها الرضى بالله وعن الله، والقناعة بما قسم الله،
الاستعداد للقاء الله. (فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة
ربه أحدا)[55].
وسائل
التبليغ:
إذا تم
التعرف على على أركان التبليغ وما يشترط فيها من الصفات، وخصوصا المبلغ الذي هو محور
التبليغ، ونجاحها أو خفوقها متوقف عليه في الغالب، يأتي الحديث عن وسائل التبليغ،
والمراد بها المنابر والوسائل المتاحة لتبليغ الرسالة من خلالها، وهي متنوعة
ومتعددة، ويأتي في مقدمة هذه الوسائل:
1- خطبة الجمعة.
تعتبر
خطبة الجمعة المنبر الأول والأساس في تبليغ الدعوة، منذ أن أقام النبي ﷺ صلاة الجمعة مع خطبتها في المدينة المنورة في أول يوم
نزل بها، ولأهمتة هذه الوسيلة بادر النبي ﷺ بإقامتها يوم نزوله من قباء في اتجاه قلب المدينة حيث
مسجده الآن، فحان وقت الصلاة وهو في الطريق فصلى بالصحابة المرافقين له
والمستقبلين له صلاة الجمعة وخطب فيها خطبته المشهورة، في ديار بني سالم، حيث بني
المسجد المعروف إلى اليوم بمسجد الجمعة.
وهي
أول جمعة صلاها النبي ﷺ،
بالمدينة المنورة، بل منذ بعثه الله برسالة الإسلام؛ إذ مكة لا يسمح له فيها
بإقامة الشعائر كالأذان والجمعة والعيدين وغير ذلك.
والمقصود
من ذكر أول جمعة في أول يوم نزل فيه النبي ﷺ، استفادة أهمية الجمعة وما تقدمه للمجتمع من التلاوة
والتزكية والتعليم، وما يتفرع عن هذه الثلاث من أمور العقيدة والعبادة والمعاملات
والأخلاق، ومن خلالها تعلم الصحابة رضي الله عنهم دينهم، في وقت وجيز لا يتجاوز
عشر سنوات، فكان هداة مهديين، فتحوا الدنيا وكانوا أنموذجا في التخلي والتحلي،
وتحلية غيرهم من التابعين الذين تربوا على أيديهم. فتخلصوا من الكفر والشرك
بأنواعه المختلفة، فلا عبادة للأصنام بعد، ولا رياء ولا أنانية ولا كبر ولا يحملون
في نفوسهم شحا ولا بخلا ولو كان بهم خصاصة.
وليس
ببعيد على من أراد أن يصلح حاله وحال غيره إذا صحت عزيمته، وأخذ بما أخذوا به من
الجد والتجرد لفعل الخير من خلال صدق الإيمان والعمل الصالح.
وخطبة
الجمعة عظيمة الشأن جديرة بالتقديس والاحترام؛ لأنها ميراث النبي ﷺ، الذي ورثه عنه العلماء، ونيابة عن أمير المومنين، في
تفقيه الأمة وترشيدها وتعليمها أمور دينها، ولذا لا يجوز لأحد أن يعترض على الإمام
وهو يخطب، بل لا يجوز الكلام وما في حكمه، وإنما الإنصات التام والسكون الكامل
لجميع الجوارح؛ لتقلي أمر الله ونهيه من الخطيب لكي تعمل به ابتداء من ساعتك التي
سمعته فيها، وتتزود منها إلى الجمعة الأخرى.
وعليه،
فيجب على الخطيب أن يقدر هذه المسئولية حق قدرها، وأن يعيرها من الاهتمام ما تستحق
من الأمور الآتية:
-
الإخلاص فيها لله تعالى؛ بحيث يكون القصد أداء الرسالة
على أحسن وجه وأكمله.
-
أن تكون الخطبة صحيحة من حيث مضامينها المنبثقة من
الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من هذه الأمة. فلا مجال فيها لتضييع الوقت بما لا
يصح ثبوتا ومعنى، ولا مجال فيها للانشغال بالقيل والقال وشغل الناس بما حدث أو
يحدث في شرق الدنيا أو غربها، وإنما يحصر الخطيب مهمته في ينفع الناس ويعود عليهم
بعظيم العائدة في دنياهم وأخراهم حتى يعيشوا حياة طيبة بما يتلقونه من النصائح
والتعاليم والمواعظ.
-
أن تكون الخطبة سالمة من التشويش والتشهير والإشهار،
فالمسجد ليس مجال للحزبية والفئوية والعرقية، فلا يجوز تسخير الخطبة لمدح فئة أو
ذم أخرى، وإنما لنصح الجميع بالتمسك بما أمر الله به ورسوله. واجتناب ما نهى عنه.
-
أن يكون الخطيب حاملا لهم الخطبة طيلة أسبوع لأنه مسئول
عما يلقيه على الناس أمام الله تعالى وأمام الناس، فليتق الله تعالى في خلقه.
وهذه فقط بعض النقاط المساعدة على نجاح
الخطيب في خطبته، وهناك نقاط أخرى تندرج في ما تقدم.
2- الموعظة في المسجد أو في أماكن
مختلفة
الموعظة
شأنها شأن الخطبة من حيث المضمون والمطلوب، إلا أنها أخف من حيث الشكل والأداء،
فالموعظة هي ترغيب وترهيب حسب ما يقتضه المقام، مع مراعاة الناس وأخذهم بالتيسير
وتسهيل الصعاب عليهم، كما قال النبي ﷺ: "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تُبَغِّض
إلى نفسك عبادةَ ربك فإن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى"[56].
فالمبلغ
عن رب العالمين لا بد أن يتسم بالإخلاص والصدق والنصح والصبر، وعدم استعجال
النتائج، وعدم تأييس الناس وتقنيطهم وعدم حملهم على الدين بالمرة؛ لأنه إذا أراد
أن يحملهم على الحق بالمرة تركوه بالمرة.
وفي
حلقات الوعظ يستطيع الواعظ أن يبين ويشرح
ويسأل ويجيب ويناقش في حدود المعقول، لا أن يفتح المجال للمرتابين والمشككين
وأدعياء المعرفة أن يشوشوا على مجلسه، فلا بد أن يحافظ على هيبة الدرس الديني
ليستفيد الناس ويضيفوا إلى معارفهم المزيد لا أن يزدادوا ارتيابا فيما هم عليه.
والدرس
الوعظي قد يكون في المسجد أو في بيت من بيوت الناس أو في أي مكان يراه الواعظ
مناسبا لموعظته. كما كان النبي ﷺ يفعل
حيث يغتنم كل فرصة سانحة لتوجيه الناس وتقديم موعظة هادفة لهم. ومن خلال ذلك تعلم
الصاحبة ولزموا من أجل ذلك رسول الله ﷺ في حركاته وسكناته وسفره وحضره.
فأحصوا أفعاله
وأقواله وتقريراته إحصاء لم يتسن لأحد قبله ولا بعده. ودون العلماء ذلك في دواوين
السنة والسيرة تدوينا كاملا.
3-
الكتابة سواء في الورق أو في المواقع الرقمية
من وسائل
التبليغ الناجعة والمفيدة كذلك الكتابة في مواضيع الدين والدنيا التي تهم الناس في
حياتهم اليومية، فالكتاب خالد ويخلد معه الانتفاع به ويسهل تنقله أكثر من تنقل
صاحبه، ولذلك أقسم الله تعالى بالقلم وما يسطر به من العلوم والمعارف في قوله
سبحانه: (ن والقلم وما يسطرون)[57].
واعتنى
السلف الصالح بكتابة العلم بدءا بكتابة المصحف الشريف والسنة النبوية وما يخدمهما
من العلوم المختلفة.
ولا توجد
أمة تملك من التراث المكتوب عبر ا أجيال ما تملكه أمة الإسلام التي فجرت على الناس
أنهار المعارف في مختلف الفنون.
ولذا
كانت الكتابة من أهم وسائل الدعوة والتبليغ عن الله تعالى وعن رسوله سيدنا محمد ﷺ.
ومما
استجد في حياة الناس اليوم ويجب استغلاله أحسن استغلال الكتابة الرقمية في المواقع
الإكترونية، فهذه المواقع مفروضة على المجتمع المسلم كأي مجتمع آخر على وجه،
وداخلة إلى كل بيت من غير استئذان، فلا مناص منها، وعليه فيجب استغلالها لصالح
دعوة الإسلام، ولتكن من بين الوسائل التي يعتمدها الدعاة والمبلغون عن الله تعالى،
مع الحذر مما يأتي منها أو مما يكتب المبلغ فيها، فلا بد من استحضار القاعدة
الذهبية التي قالها علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن
يكذب الله ورسوله"[58]، وقال ابن مسعود، رضي الله
عنه: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"[59].
فهذان
الأثران من الصحابيين الجليلين قاعدة ذهبية لكل من تصدر للتبليغ والدعوة إلى الله
تعالى، في مراعاة أحوال المخاطبين المختلفة.
ولهذا يشترط
أن تكون الكتابة بكل أنواعها وأشكالها رصينة مضبوطة بالضوابط التي تنضبط بها
الخطبة والموعظة، ولا ينسى الكاتب نفسه فيحلق سماء الغربة والعزلة بعيدا عن
المجتمع وهمومه، فيبهم أكثر مما يفهم، ويشدد أكثر مما ييسر، فالواعظ والخطيب
والكاتب وغيرهم ممن يتكلمون في مجال الدين لا يتكلمون مع أنفسهم وبما هم به
مقتنعون، وإنما يتكلمون مع الناس وما هم في حاجة إليه، في إطار ثوابتهم وأعرافهم
وعاداتهم وأحوالهم.
فإن
راعوا هذه الخصوصيات نجحوا وبلغوا بالتبليغ غايته، وإلا، يصدق فيهم المثل العربي:
"أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"
فالعبرة
بالأثر وبالوسائل التي تحدثه، وخصوصا الأثر الذي تبحث عنه خطة تسديد التبليغ الذي هو
الاستقامة والتدين السليم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وتقليل الكلفة على الناس
ورفع الحرج والعنت عنهم، كما قال الله تعالى عن نبيه ﷺ، سيد المبلغين: (لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما
عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم)[60].
فإذا
تحققت هذه النقاط، فقد آتت الجهود الطيبة أكلها، وسعد الناس بها وعاشوا حياة طيبة
كما وعدهم الله تعالى بها. بكل اطمئنان وسكينة وسهولة ويسر. وما ذلك على الله
بعزيز إذا توفرت الإرادات وصحت العزائم وخلصت النيات.
4-
الكلمة الطيبة في مجلس أو لقاء ما في مكان ما
الكلمة
الطيبة صدقة كما قال النبي ﷺ، ولذلك
تعتبر الكلمة الطيبة من أهم وسائل الدعوة وأسهلها وأكثرها انتشارا، ولذلك نجد
النبي ﷺ، لا
يترك فرصة سانحة إلا وأرسل فيها كلمة أو كلمتين، وكانت كلماته ﷺ هادفة وموجزة ومختصرة.
فلو
تتبعنا معظم أحاديث رسول الله ﷺ،
ومناسباتها وأسباب ورودها لوجدناها قيلت في مناسبات عدة تجمع بين الحضر والسفر
والخاص والعام والرجال والنساء والأطفال وغيرهم من شرائح المجتمع المدني.
وهذا ما
يدعو المبلغ عن الله إلى استحضار الدعوة في كل مكان وبلسان الحال قبل المقال،
وتوخي الحكمة وإصابة الحق فيما يصدر منه من قول أو فعل أو حال.
وغير ما
ذكر من الوسائل المختلفة في تبليغ الرسالة للغير. وإنما ذكرت أهمها وأشهرها
وأكثرها دورانا في حياة الناس.
وأعود
وأؤكد فأقول: لا بد لكل هذه الوسائل أن تكون مؤطرة بالثوابت الدينية والوطنية
للبلاد من أجل البناء ومساعدة الناس على الانخراط في مشروع العلماء الممثل في خطة
تسديد التبليغ والمحافظة على أمنهم الروحي وسلمهم الاجتماعي وتخفيف كلف الحياة
عنهم بإقناعهم بالاستغناء عما يضرهم وعما لا يفيدهم وما لا يعنيهم.
غايات
التبليغ:
غايات
التبليغ هي الثمار المرجوة من كل ما تقدم ذكره، ويمكن تقسيم هذه الغايات إلى قسمين
كبيرين:
القسم
الأول: امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه ابتغاء مرضاته، وجزيل عطائه في الدنيا
والآخرة
القسم
الثاني: ما يرجى من تحقيق الحياة الطيبة للناس كما وعد بها الحق سبحانه وتعالى
بشرطيها الإيمان والعمل الصالح.
وفي يأتي تفصيل ذلك وبيانه بإذن الله تعالى:
القسم
الأول من غايات التبليغ: ابتغاء مرضاة الله تعالى
مما هو
معلوم من الدين ضرورة أن الله تعالى خلقنا لعبادته، كما قال جل في علاه: (وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون)[61].
وعلى هذا
الأساس ابتعث رسله وأنبياءه، وأنزل كتبه ورسائله، كل ذلك هدى للناس وبينات من
الهدى والفرقان؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة.
وهذا هو
الدين المشار إليه في قوله تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)[62].
وهو
الدين الإسلامي المرضي عند الله تعالى كما قال سبحانه: (إن الدين عند الله
الإسلام)[63]،
وقال جل شأنه: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من
الخاسرين)[64].
وأصوله
في المعتقدات والمعاملات والأخلاق لا تختلف، وإنما الاختلاف في الشرائع التي راعى
فيها الحق سبحانه أحوال عباده، رفقا بهم ورعاية لمصالحهم، كما قال سبحانه: (لكل
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)[65].
ولا يدل
ذلك على البداء أو الظهور بعد الخفاء؛ وإنما المراد منه التيسير الذي هو سمة
الشرائع السماوية، ومجانبة التعسير الذي يتنافى مع طبيعة البشر.
ولما بعث
الله رسوله محمدا ﷺ، ختم
برسالته الرسالات وبنبوته النبوات، فلا نبي بعده ولا رسالة تنزل بعد القرآن، فكان
هذا منشأ كون القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، وأمينا عليها في أصولها، وناسخا
لما لم يعد صالحا من الشرائع السابقة، ومحافظا على ما هو صالح لكل زمان ومكان.
كما كان كذلك
منشأً لشمولية رسالة القرآن لجميع مناحي حياة الناس، ولجميع أنواعهم مع اختلاف
الأجناس والأعراق والألوان، واختار الله تعالى لهذه الرسالة اللغة العربية لتكون
وعاء خاتمة الرسائل السماوية، وبيانا لها مع ما تضمنته من الإعجاز الذي لا يوجد في
غيرها من اللغات، مع تمام البيان وكمال الوضوح.
فقام
النبي ﷺ من هذا
المنطلق الشامل الجامع لتبليغ رسالته في تحقيق العبودية لله تعالى، وتحقيق الحياة
الطيبة للناس في حياتهم اليومية، وإصلاح وتسديد تدينهم لكي يؤتي ثماره المرجوة
منه، في انسجام كامل وتوافق تام بين حقوق الله تعالى وحقوق عباده. وتلك هي غايات
التبليغ وأهدافه الكبرى:
الغاية
الأولى: تحقيق التوحيد لله تعالى
لا شك أن
الغاية من الخلق كله هي توحيد الله وتعالى وإفراده بالعبادة، كما نصت عليه الآيات،
وجاءت به الأحاديث، فالكون كله خلقه الله تعالى للإنسان، والإنسان خلقه لعبادته،
كما قال الله تعالى: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون)[66]. وقال جل شأنه: (والأرض
وضعها للأنام)[67].
إذاً
فالغاية التي تنزلت الشرائع من أجلها هي تحقيق العبادة لله تعالى مع الإخلاص فيها،
وهو المراد بالتوحيد؛ توحيده عبادة وتوحيده عبودية.
وعلى هذا
الأساس جاء المبلغون يبلغون، ويراقبون الله تعالى في تبليغهم، من غير خوف ولا طمع،
(الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا)[68].
وعلى هذا
الأساس يجب أن يعمل العلماء في تسديد التبليغ تحقيقا لهذه الغاية الكبرى، والهدف الأسمى،
من أجل تخليص العباد لله تعالى من الشرك الظاهر ومن الشرك الخفي، الذي هو عبادة
النفس والهوى وما يمليه عليهما الشيطان، وهذا النوع من الشرك هو الأخطر لخفائه
ولمجيئه من بين أضلع الإنسان، وما يصاحبه من التزيين، وما يحفه من الشهوات التي
تغطي خطورته وعيوبه.
فالتوحيد
إذا تحقق سهل على المبلغين والمبلغ إليهم أن يحققوا نتائج مرضية في جميع
المستويات، لأنهم بتحرير الإنسان من نفسه، قد أصبحوا قاطعين أشواطا كبيرة في تحقيق
الهدف لصالح الدين والدنيا، وأعطوا للدين معناه الصحيح، وأدركوا أن ممارسته هي
الغاية في تربية الإنسان وتعليمه، حتى يصبح متدينا.
والتدين
هو التخلق بأخلاق الدين في التزام الأمر واجتناب النهي، مع استحضار المراقبة
الدائمة لله تعالى، وصرف كل حركة أو سكون في مرضاته، وهذه هي مرتبة الإحسان؛ كما
قال النبي ﷺ:
"أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"[69].
وهنا
تفنى الأعمار ويتنافس المتنافسون في سباق، متفاوتين في المراتب والدرجات، كل وما
أداه إليه جهده ومجاهدته، وكلا وعد الله الحسنى، (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا وإن الله لمع المحسنين)[70].
الغاية
الثانية: تحقيق مصالح العباد
وهذه
الغاية ليست غاية مستقلة يمكن تحقيقها بعيدا عن الغاية الأولى، وإنما هي فرع عنها
متوقفة عليها، فلا سبيل إلى الوصول إليها إلا عبر الغاية الأولى.
ومن ثم
فلا تنتظر ممن تنكر لله تعالى وعانده في أمره ونهيه أن يحقق العدل بين الناس، وأن
ينصفهم بتحقيق مصالحهم الدنيوية بعيدا عن النظر إلى دار الجزاء والإيمان به، وكل
ما يدعيه الناس من تحقيق العدل والقيام بمصالح الناس بلا إيمان بالله تعالى ولا
التزام بشريعته فهو موهوم، قائم على أساس الخوف من النيل من الجيوب، فالتزم الجميع
ظاهرا، إن كان هناك التزام، فوقف كل فرد في مساحة محددة له محبوسا عن فعل الخير،
مردوعا بالقوانين الزاجرة التي تحيط به من كل جانب.
وكلما
سنحت له الفرصة ليخون ما تردد؛ لأنه لم يكن الوازع من داخله ليحاسبه، وإنما أبيحت
له المخالفات الهدامة، فلا زاجر ولا مانع، فيظن أنه يمارس شيئا اسمه الحرية، في
خرق أعراض الناس وأكل أموالهم بالباطل، وغير ذلك من صنوف الإجرام المشرعنة، إن صح
هذا التعبير.
ولكن في
ظل هذا النوع من العيش هل هناك حياة طيبة؟ هل هناك شيء اسمه الأسرة وحنينها
وعطفها؟ هل هناك شيء اسمه الرحم والبرور بأهلها؟ هل هناك عناية بجوانب مهمة في
الإنسان تحتاج إلى العناية بها مثل روحه ومشاعره وأحاسيسه، وحبه للغير وإيثاره على
نفسه، وسعيه لتحقيق سعادة الآخرين؟
كل شيء
من ذلك لا يوجد، سوى الأنانية المطلقة، والأثرة المطبقة، والأخلاق المصطنعة لتلبية
الشهوات والرغبات الحيوانية في الإنسان.
أما في
التوحيد وتحرير الإنسان من الشبهات والشهوات، فإن الحياة الطيبة تتحقق بكل
أبعادها، وليس في البعد المادي وحده، كما قد يتوهم البعض، وإنما في بحث الإنسان عن
قيمته أولا، وأين تكمن. وعن سعة أفقه الشامل لعالم الغيب وعالم الشهادة، وعن حياته
الممتدة من الدنيا إلى الآخرة، فلا يشعر بالفناء وقربه منه، بل يحس بالحياة
الأبدية قبل أن يصل إليها، ويجني ثمارها في الدنيا عن طريق السعادة التي تملأ قلبه
بالعبودية لله تعالى، وحب إخوانه لله لا لشيء آخر، وإيثاره لهم على نفسه رغبة فيما
عند الله تعالى، لا خوفا من أحد.
وبهذا يعيش
الإنسان المسلم كما ذكرت سورة العصر بين الإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق
والتواصي بالصبر، في حين يعيش غيره في خسران مبين، بين الهلع والجزع والمنع لحقوق
الآخرين، يبني ما ينهدم، ويجمع ما يفنى، ولا ينفذ بصره إلى عالم آخر ليطمع فيه،
ولا يمكن أن يطمئن إلى الخلود هنا؛ لأنه مما لا مطمع فيه، فيضيع في هذه الدنيا
ويتيه، ويحتار في ما يختاره أيذره أم يأتيه.
وغاية
تسديد خطة التبليغ التي قام بها العلماء أداء للواجب المنوط بأعناقهم، ووفاء لولي
الأمر، ونصحا للمومنين، هي إصلاح ما يمكن إصلاحه من تحرير الناس مما هم فيه، عن
طريق ربطهم بالذي خلقهم ورزقهم؛ ليعلموا ما للنفس وما عليها، فيكفوا مؤونة العنت
والحرج المنبعث من الجهل أحيانا، ومن اتباع الهوى أحيانا أخرى.
ولا يكون
ذلك إلا بالعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، من الإيمان المفيد لليقين،
والتفاني في العمل الصالح، والإيثار للغير في إسداء المعروف، ودرء المكروه، وقد
كان الإمام مالك، رحمه الله، يكرر قوله: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح
به أولها"[71].
فهذه
قاعدة عظيمة، وكلمة جامعة من الإمام، رحمه الله تعالى، يجب الاستفادة منها بالبحث
عما صلح به أول هذه الأمة، وسيجد الباحث الجواب في بيان القرآن الكريم وبيان السنة
النبوية ومنهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الملخص في التلاوة والتزكية
والتعليم، مع مراعاة الزمان والمكان والحال، والأخذ بالتيسير والتدرج في سبيل
الإصلاح. كل ذلك في إطار الثوابت الدينية مع اختيارات ا أمة في ما تقتضيه المصلحة
لتدبير الشأن العام.
فإن تم
التركيز على هذه المصادر والمناهج فإنه سيثمر الإخلاص، وهو رأس مال المسلم، ويثمر
العمل الصالح، وهو زاده، وينتج الأخلاق الحميدة، وهي ربحه، وينظر إلى الحياة على
أنها مطية الآخرة، وكل الحركات والسكنات فيها محسوبة ومحاسب عليها، فتنقلب كلها
عبادات، ويصبح التدين منضبطا بضوابط الشرع الحكيم، فيعيش المسلم بذلك حياة طيبة،
كما وعده الحق سبحانه وتعالى بذلك في محكم تنزيله، ويسري على من بجانبه ما يسري
عليه من الطمأنينة والسعادة الدائمة، ويكون من الذين إذا رؤوا ذكر الله، كما جاء
في قول النبي ﷺ:
"ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم الذين إذا رءوا ذكر
الله"[72].
ومن الذين يجعل الله لهم نورا يمشون به في الناس، وتصرفاتهم كشجرة طيبة تؤتي أكلها
كل حين بإذن ربها.
ويصدق
فيهم قول النبي ﷺ:
"عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر،
فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له"[73].
الخاتمة
وفي
الختام أقول: لا شك أن الشروط المذكورة في هذا العرض فيما يتعلق بكل من المبلغ
والمبلغ إليه وطريقة التبليغ، ومراعاة كل ما سبق زمانا ومكانا وحالا، أنها ستنتج
المقصود منها وتبلغ الغاية التي رسمت لها محققة بذلك أمل العلماء في تحقيق الحياة
الطيبة للناس، في ربطهم بالله تعالى إيمانا وإخلاصا ورضى بحكمه في سائر الأحوال،
وفي تحسين علاقاتهم بعضهم ببعض بما يثمر المحبة والمودة والشعور بحاجة الآخر
والسعي في إسعاده ورفع الحرج عنه امتثالا لقول الله تعالى، في بيان مهمة رسوله
المصطفى ﷺ: (لقد
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم)[74].
والحمد
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم في كل بدء وختام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحسن بن
الحسين إد سعيد السكتاني السوسي لطف الله به وبالمسلمين أجمعين.
[1] - الإسراء 15.
[2] - البقرة 38.
[3] - المائدة 67.
[4] - المائدة 67.
[5] - الأعراف 62.
[6] - الأعراف 68.
[7] - الأحقاف 23.
[8] - المائدة 99.
[9] - إبراهيم 52.
[10] - الأحقاف 35.
[11] - صحيح البخاري باب ما
ذكر عن بني إسرائيل، 4/170.
[12] - سنن أبي داود باب فضل
نشر العلم، 3/322. وسنن الترمذي باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، 5/33.
[13] - صحيح البخاري كتاب
العلم باب ليبلغ الشاهد الغائب، 1/33.
[14] - المائدة 3.
[15] - تراجع قصة أبي سفيان
مع هرقل في صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، 1/8.
[16] - صحيح البخاري كتاب
بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ﷺ، 1/7.
[17] - الأنعام 122.
[18] - ألفية العراقي في
علوم الحديث، باب آداب المحدث، 1/154.
[19] - صحيح البخاري كتاب
الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل، 4/60.
[20] - فصلت 33.
[21] - هود 88.
[22] - البيتان لعبد الله بن
همام السلولي التابعي، تاريخ دمشق لابن عساكر، 33/351.
[23] - المستدرك للحاكم،
كتاب الرقاق، 4/455.
[24] - الحشر 9.
[25] - صحيح مسلم باب إكرام
الضيف، 3/1624.
[26] - صحيح ابن حبان، باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الآية نزلت في بني هاشم، 16/255.
[27] - البيت مشهور وغير
منسوب، وهو من شواهد الألفية، ينظر شرح ابن عقيل على الألفية، 1/332.
[28] - البيتان للإمام
الشافعي.
[29] - الأنعام 90.
[30] - يونس 72.
[31] - هود 29.
[32] - هود 51.
[33] - سبأ 47.
[34] - آل عمران 79.
[35] - صحيح البخاري، كتاب
العلم، باب العلم قبل القول والعمل، 1/26.
[36] - سنن أبي داود باب في
الاستغفار 2/631.
[37] - سنن أبي داود، باب
إخبار الرجل الرجل بمحبته، 4/332. والأدب المفرد للبخاري، 1/124.
[38] - يوسف 108.
[39] - لقمان 27
[40] - الاعتبار في الناسخ
والمنسوخ للحازمي ¼.
[41] - منهج النقد في علوم
الحديث، 1/336.
[42] - صحيح البخاري كتاب
العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم، 1/37.
[43] - صحيح مسلم باب النهي
عن الحديث بكل ما سمع، 1/11.
[44] - آل عمران 7.
[45] - سنن الدارمي باب في
كراهية أخذ الرأي 1/234.
[46] - الأبيات لابن الرومي
.
[47] - الرعد 40.
[48] - الأبيات لأبي حيان
النحوي الأندلسي، من نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقري 2/564.
[49] - التوبة 129.
[50] - الحجرات 7.
[51] - التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي، 1/639.
[52] - صحيح البخاري باب
رحمة الناس والبهائم، 8/10. رقم 6010.
[53] - صحيح البخاري كتاب
النكاح باب الترغيب في النكاح، 7/2. رقم 5063.
[54] - الرسالة لابن أبي زيد
القيرواني، باب في الأقضية والشهادات، 1/132.
[55] - الكهف 110.
[56] - شعب الإيمان للبيهقي
باب القصد في العبادة، 3/401.
[57] - القلم 1.
[58] - صحيح البخاري كتاب
العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم، 1/37.
[59] - مقدمة صحيح مسلم
1/11.
[60] - التوبة 128.
[61] - الذاريات 56.
[62] - الشورى 13.
[63] - آل عمران 19.
[64] - آل عمران 85.
[65] - المائدة 48.
[66] - الجاثية 13.
[67] - الرحمن 10.
[68] - الأحزاب
[69] - صحيح البخاري كتاب
الإيمان باب سؤال جبريل النبي ﷺ، عن الإيمان والإسلام والإحسان، 1/19.
[70] - العنكبوت 69.
[71] - الشفا بتعريف حقوق
المصطفى للقاضي عياض القسم الثاني الباب الرابع، الفصل التاسع في حكم زيارة قبره ﷺ، 2/205.
[72] - سنن ابن ماجة باب من
لا يوبه له، 5/236.
[73] - صحيح مسلم كتاب الزهد
والرقاق باب المؤمن أمره كله خير، 4/227.
[74] - التوبة 128.